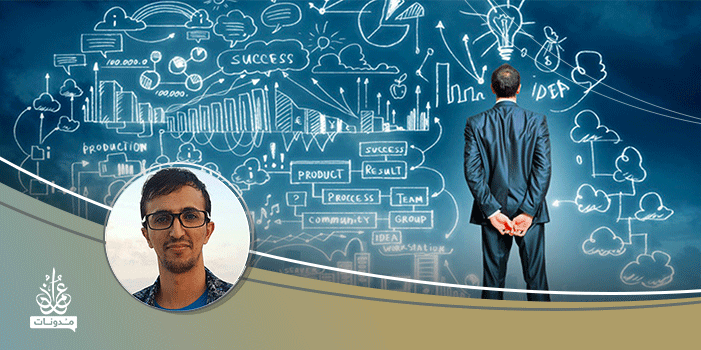في المقال السابق بين الذهنية الفكرية والعملية تطرقنا لتساؤلات عدة عن ذهنية الفكر وذهنية العمل، ووُضِع المقال الأول كمقدمة طَرحت جُملة من الخصائص والمُميزات التي تتصف بها كل ذهنية على حدة، وكيف أن العائلة تُعتبر عاملا أساسيا تُعطي المدخلات الأساسية، التي تتشكل من خلالها كلا الذهنيتين.
ثم في معرض كلامنا طرحنا هذه التساؤلات: هل نحن أمام تقسيم لا يقبل الثنائية بين الفكر والعمل؟ أم أن الأمر يحدث بالغلبة لأحدهم على الآخر في الفرد، وبالتالي هو محسوبٌ على ما يغلب فيه، إما فكر، وإما عمل. وهما سلفاً يحدثان بالاكتساب في الفرد، تُعملهُما جُملة من العوامل الاجتماعية والسياسية والطبيعية، كما سنبين ذلك في معرض اختيارنا لأحد المجتمعات العربية التي تتصف بالذهنية العملية، والتي سنجري عليها القياس في مقالات قادمة، نحلل من خلالها بنية تلك الذهنية، وكيف تشكلت مع الزمن، حتى أصبحت منهجية في المجتمع.
أنهينا المقال السابق بتساؤلات أخيرة قلنا فيها: ما هو الإشكال في أن يكون (س) عملي و(ص) فكري؟ وهل بالإمكان أن يُجمع بينهما، سواءً في فرد واحد أو في بيئة عمل واحدة؟ ما هي الأثار المترتبة في قيام أحدهما بمهمة الثاني والعكس؟
يسمي الأديب والمفكر العربي توفيق الحكيم "الفكر والعمل" في كتابه "الإسلام والتعادلية"، بالفكر والسلطان، فهو يجعل السلطان من أهل العمل، ثم يقول: "إما أن ينجح الفكر في توجيه العمل، وإما أن ينجح العمل في خنق الفكر، ثم يسأل ما هو الفكر وما هو العمل؟
وللإجابة عن هذا السؤال يتصور الحكيم رجل يعيش على جزيرة نائية بمفرده، هذا الرجل لا شك يعمل في النهار ليوفر لنفسه المأكل والملبس والمأوى، يقطف الثمار ويصنع من الأغصان كوخاً، وينسج من الألياف ثياباً، أي يُباشر العمل للضرورة المادية، وإذا جاء وقت الراحة أرسل بصره إلى السماء الصافية، بدأ يفكر في حاله قائلا لنفسه: من أنا؟ وما معنى حياتي؟ أهي تسرني، ثم هو يدرك الجمال، إذ هو أبدى إعجابه بالأشياء، ثم من الإعجاب إذ هو يشعر بوعي التمني، حتى إذا ما شعر بقيمة الأفضلية، فحاضره إذن لا يعجبه، إذاً هو ينتقد وضعه وواقعه، يوسع في الكوخ، وينظر في البحر فإذا هو يُريد صناعة قارب لكي يستكشف الجزيرة من حوله، وقد يتمكن من استكشاف جزيرة أخرى قريبة منه. يقول الحكيم هذا هو ما نسميه التفكير...
ثم يقول وقد يؤدي هذا التفكير إلى العمل، فينهض هذا الرجل في اليوم التالي ليحقق بالفعل كل أو بعض ما فكر فيه، وقد يصادف من العوائق والصعوبات ما يصرفه عن تحقيق أفكاره، فيكتفي بعمله اليومي المعتاد ويجلس يسخر من تفكيره، ويهزأ بتبرمه ونقده لوضعه، وهكذا كما يقول في البداية، إما أن ينجح الفكر في توجيه العمل، أو أن يخنق العمل الفكر [1]. بمعنى أنهما لا يجتمعا في رجل واحد، وإذا حصل أن اجتمعا فأحدهما سيخنق الآخر.
يتساءل بعد ذلك الحكيم ويقول: ماذا لو هبط على الجزيرة رجلان، أي مجتمع صغير، وكان أحدهما أقوى عملا والآخر أقوى فكراً، فما الذي سيحدث؟
يقول ما من شك أن أحدهما سوف يؤثر في الآخر، فإما أن يظهر سلطان العمل فيخضع الفكر لإرادته، وإما أن يظهر سلطان الفكر ويوجه العمل حسب مشيئته، وإما أن يحتفظ كل منهما بسلطان معادل تجاه الآخر، فيكون التوازن الذي يحد من انفراد الآخر بالسيطرة، ثم يقول وإذا انتقلنا من هذا المجتمع إلى مجتمع أكبر منه في الأمم والشعوب.
فإننا نجد الصراع بين هاتين الفرقتين: قوة الفكر وقوة العمل، يحتل الجزء الأكبر من تاريخ البشرية، فالعمل حسب قوله يمثل السلطة المادية التي تتولى أمور الناس بالفعل، والفكر ممثل في السلطة الروحية التي تبصر وتنقد وتفتح للناس الآفاق التي يمكن أن يمتد إليها تطور الإنسان [2].
يذكر علي شريعتي في معرض كلامه عن المفكر في كتابه "الهجرة إلى الذات"، أن "رسالة المفكر ليست القيادة السياسية للمجتمع، والقيادة هنا هي أمر عملي فشريعتي يضعهما في تقابل، ثم يضيف وبالرغم من أن القائد السياسي يستطيع أن يكون مفكرًا".
في هذا السياق الذي ذكره شريعتي، يعود توفيق الحكيم ليعالج هذه الثنائية فيقول: في العصر الحديث يتعرض «الفكر» لعين الخطر، ولكن في صورة جديدة، فالحكم الديمقراطي أو الشعبي لا يستطيع في كل الأحوال أن يخفض صوت «الفكر» الحر قهراً وغصباً، ولكنه يستطيع أن يُلغي وجوده إلغاءً، بأن يُستدرج الفكر استدراجاً إلى حظيرة السياسة العملية، ومتى دخل رجل الفكر تلك الحظيرة فقد بطل نقده وتوجيهه وتفسيره، وأصبح منضما إلى نظام معين، يسير في اتجاهه، ويعمل بتعليماته، ويخضع لإرشاداته، وبذلك يكون الحزب السياسي قد تجنب فكراً طليقاً مناهضاً لإرادته، ليكتسب جندياً مطيعاً يأتمر بأوامره [3].
يطول الكلام في الجدلية القائمة بين الفكر والعمل، وفي التاريخ قرائن كثيرة تذكر لنا سيطرة أحدهما على الآخر، وما صراع الإنسان في التاريخ كما يقول توفيق الحكيم، إلا بين أهل الفكر والعمل، وغالباً ما ساد العمل وهيمن على الفكر، وفي المقابل كان الفكر هو المعارض الدائم لأهل العمل، وهذا لا يعني أن أهل العمل لم يكونوا يفكروا، وإنما بنية المجتمع أنتجت تفكير عملي.
والفكر قد يُلازم العمل، لكنه لا يندمج فيه بل يتجاوزه ويستقل عنه، يحدث التلازم حينما نقول إن العمل يعتبر أداة مهمة تُسهم في تطوير الفكر من خلال الواقع، دون أن تسيطر عليه، ويحدث ذلك أيضا حينما يصوغ الفكر المبادئ والقيم العامة التي تمنع العمل أن ينفرد بالواقع ويهيمن عليه، فهو الرقيب الحسيب دون أن يستغل من قبل العمل.
يقول خليل قويعة، عن العلاقة التلازمية بين الفكر والعمل، في كتابه "العمل الفني وتحولاته بين النظر والنظرية (محاولة في إنشائية النظر)" الصادر عن المركز العربي للدراسات والسياسات، نقلاً عن المفكر باسرون إن العمل الإبداعي هو فكر في حالة عمل وهي مقاربة تعود بكل من الفكر والعمل إلى أطوارهما التكوينية الباكرة. ثم يضيف قويعة، إلا أننا ها هنا في عُرف هذه المقاربة التكوينية بصدد علاقة تلازمية بين الفكر والعمل، فلا قيام للواحد من دون الآخر، ولا الواحد منهما سابق على الآخر أو لاحق له، بل أن ما يسبق هذه الثنائية هي حالة سديمية.
بعد هذا العرض لديمومة العلاقة الجدلية بين الطرفين "الفكر والعمل"، سنتطرق في المقال القادم لدراسة بنية أحد المجتمعات العربي، والتي نفترض أنه مجتمع تغلب عليه الذهنية العملية، سنشرح بنية ذلك المجتمع، ونرى كيف ساهمت جملة من العوامل الاجتماعية والسياسية والطبيعية في تشكلها.