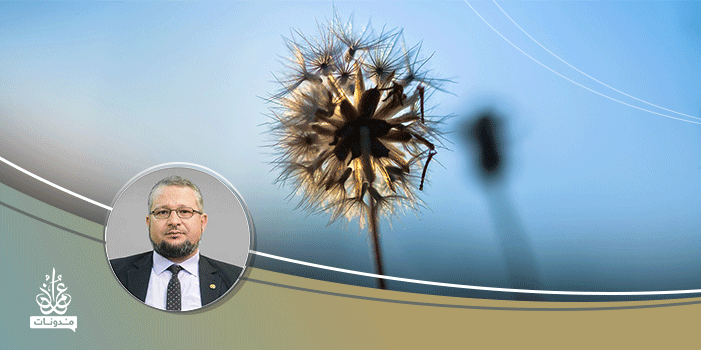لا زلنا نعاني من موجاتٍ عصيّة على التغيير ومقاومَةٍ شرسةٍ له، من قِبل أنظمةٍ لها القدرة على التحكّم وإعادة الرّسكلة، وخاصّة في ظلّ غياب القوى التي تضع نفسها في المكان المناسب، عندما تتحرّك الدورات الحضارية وفق السّنن الكونية والاجتماعية ولا تجد مَن يتناغم معها، كما يقول الدكتور عبدالرزاق مقري الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة.
وجاءت انتكاسة الرّبيع العربي، بعد عسكرته ودخول فواعل خارجية على خطّه لتزيد من حالة اليأس والإحباط، بعد انتقاله من حالته الاحتجاجية العفوية إلى ثوراتٍ شعبيةٍ منتظمة، ليستيقظ الجميعُ على حالةٍ من الفوضى والفتنة والعنف، لتَنزِع عنه الشرعية وتعطِي الأنظمة المستبدّة نصاب البقاء في الحكم بشرعية مكافحة العنف والإرهاب، ومساومة الشعوب بين الأمن والاستقرار وبين الشرعية والديمقراطية.
وبعد أن خاضت النّخبُ صراعًا مريرًا مع الأنظمة لعقودٍ من الزّمن وخاصّة الحركة الإسلامية، فإنّ ذلك لم يكن كافيًّا لإحداث التغيير، إذ أنّ الشّعوبَ كانت متفرّجةً من بعيد، معتبرةً ذلك الصّراع لا يعنيها، فهو في نظرِها صراعٌ على السّلطة من أجل حكم الشّعب وليس من أجل تحريره والحكم بإرادته.
وهو ما يعني أنّ التغيير لن يحدث إلا بتناغم الإرادة بين النُّخب والشّعب، ولن يكون ذلك إلا إذا وصل الشّعور بالظلم وخطر الاستبداد إلى عامّة الناس وأغلبِهم، كما قال عبد الرّحمان الثعالبي: (فالأمّة التي لا يشعر كلُّها أو أغلبُها بآلام الاستبداد لا تستحقّ الحرّية).
ومن المشاريع الفكرية العملاقة في الوَحي الإلهي، مسألة التغيير والسّنن الشرعية والقدَرية له، وهي من المصطلحات اللاّمعة والمثيرة في القرآن الكريم، ومن المفاهيم المركزية والمحورية فيه، بنسقٍ مفاهيميٍّ متكامل، كأحدِ أهمّ المصادر المؤسِّسة للمعرفة والسّلوك.
وبالرّغم من التداول العُرفي لهذا المصطلح وفق الوضع اللغوي إلا أنّ السياق القرآني وتفاعل الوحي مع الإنسان جعلَ له وَضْعًا شرعيًّا وواقعًا دلاليًّا، فلم يتوقّف على الحقيقة اللغوية له عند العرب، بل تعدّاها إلى الحقيقة الشرعية عند المكلّفين، والتي ستكون تكليفًا إلهيًّا وليست مجرد ترفٍ فكريٍّ أو تناولٍ بلاغيٍّ مجرّد، إذ لا معنى للبناء اللغوي في عالَم الأشياء إنْ لم يتحوّل إلى البناء الشرعي الواقعي في عالم الأفكار والقيم والسّلوك، مصداقًا لقوله تعالى: "إنّ الله لا يغيّر ما بقومٍ حتى يغيّروا ما بأنفسِهم" (الرّعد:11)، وأنّ لفظة "ما" تدلّ على الشّمول والاستغراق لكلّ أحوال النّفس البشرية: الإيمانية والفكرية، والقولية والفعلية، والخلقية والسّلوكية، بل وتتجاوز التغيير على مستوى النّفس -كفرد- إلى التغيير على مستوى القوم أي المجتمع والدولة والحضارة، وهو ما ينسجم مع واجب الانتقال من الصلاح الفردي إلى الإصلاح الجماعي، بإقامة الشّهادة على الناس بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في الحديث الشّريف وقول زينب بنت جحش -رضي الله عنها-: "أَنَهلك وفينا الصّالحون؟ قال: نعم، إذا كثُر الخبث"، أي أنّ الصلاح الفردي لا يزيل العذر ولا يرفع العتب بتعطّل الإصلاح الجماعي وهو النهي عن المنكر (الخبَث)، وفي حديث السّفينة فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: ".. فإنْ ترَكوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعًا، وإنْ أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا.."، فتصبح هذه القدرة على التغيير واجبًا والتكاسل عنها إثمًا يستوجب العقوبة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، وهو يستنهض هِمَمَ التغيير والقيام بالواجب: "ما مِن قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، يقْدرون أن يغيِّروا فلا يغيِّرون، إلاَّ أصابَهم الله بعقاب".
وقد ورد مصطلح التغيير في الظواهر الحسّية للخلق في عالم الأشياء المادية بالمعنى اللغوي الظاهري في مثل قوله تعالى: "ولآمرنّهم فليغيّرنّ خلق الله.."(النساء:119)، كما ورد مصطلح التغيير في عالم القيم والأفكار في مثل قوله تعالى: "ذلك بأنّ الله لم يكُ مغيّرًا نعمةً أنعهما على قومٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهم"(الأنفال:53)، والتي تجعل من التغيير وظيفة الإنسان، وأنّها بإرادة الإنسان، وأنّ محورها وساحتها هو الإنسان، وما إرادة الله تعالى في ذلك إلا سُنّة متناغمة مع إرادة الإنسان في نفسه، وأنَّ السُّننَ ناتجةٌ عن فعل الإنسان في ممارسة أقصى طاقاته الذّهنية والعملية، فهي الأثر المتحقّق من جراء العمل، وأنّ هذا الخطاب القرآني يؤكّد على هذه الحقيقة الأزلية، والتي ترافق المسيرة الإنسانية الوجودية، بأنّ مفتاح التغيير الأساسي ينطلق من النّفس البشرية، وأنه ليس فكرةً مُرحّلةً إلى غيره.
والآية نصّت بأنّ هناك تغييران، أحدهما من الله جل جلاله والثاني من الإنسان، وأنّ العلاقة بينهما هي علاقة سُننية سببية متلازمة كعلاقة المقدّمة بالنتيجة، وهو ما يعني أنّه هناك سُننًا شرعية متمثّلة في الأسباب البشرية كمقدّمات، وسُننًا كونية متمثّلة في القدَر الإلهي كنتائج، وأنّ التشريع الرّباني جاء من أجل المطابقة بينهما حتى يحدث التغيير المنشود، بتلازم السّنن الشّرعية مع السّنن الكونية، مثل هذا الترتيب السّنني المنهجي والمحكم في قوله تعالى: "ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض" (الأعراف:96)، فمقدّمة السّنن الشرعية بالأخذ بالأسباب اختيارًا (الإيمان والتقوى) يترتّب عنها تدخّل السّنن الكونية الإلهية بالفتح عليهم من بركات السّماء والأرض كنتيجة.
وهو ما يعني الحسم المعرفي القرآني في الثنائيات الجدلية للتغيير: بين تغيير الظّاهر والباطن، وتغيير النّفس والغير، وتغيير الفكر والفعل، والتغيير الإرادي والقَدَري، بعد أن تركّزت فاعلية هذه الثنائيات في الإيمان الحي والاقتناع الواعي والاختيار الحر في نظرة الإنسان إلى الله والكون والحياة.
وهو ما يجعل هذا الاقتران بين الإيمان الحق: "أولئك هم المؤمنون حقًّا"(الأنفال:03)، مع الفعل الإرادي الحقيقي: "وأنْ ليس للإنسان إلاّ ما سَعى"(النّجم:39) قوّةً في صناعة التغيير بتفاعل الإنسان مع الحاضر والحضارة، وهو ما جاء التحذير القرآني من مخالفته في قوله تعالى: "يا أيّها الذين آمنوا لِمَا تقولون ما لا تفعلون، كَبُر مقتًا عند الله أنْ تقولوا ما لا تفعلون."(الصّف:02،03)، وهو ما يعبّر عن الإمكان السّنني في إحداث التغيير، وأنّه سُنّة كونية وشرعية مطّردة وممتدةٌ في الزّمان والمكان.
وفي قصّة الخِضر -عليه السلام- عبرةٌ في معرفة هذا الإمكان السُّنني، وتكامل القدرة الإلهية مع الإرادة البشرية في استحقاق التغيير، فهو الذي يملك ذلك الوعي المتّقد: "وعلّمناه من لدّنا علمًا"، وذلك الفعل الإرادي بمدّ يده: "فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ"، وكان السّبب في هذا الفعل المستغرَب هو الوفاء للماضي الإيجابي: "وكان أبوهُما صالحًا"، وحرّكه ذلك الإدراك الواعيُ بالحاضر وفقه الواقع: "وكان تحته كنزٌ لهما"، مسترشدًا بذلك بالتخطيط والاستشراف المستقبلي: "فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ"، ولكنّ ذلك كان وفق السّنن الإلهية المطّردة: "وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي"(الكهف:82)، فتلازمت السُّنن الشرعية بإرادة وفعل الإنسان، مع السُّنن الكونية بإرادة وقدَرِ الله تعالى في التغيير.
وكذلك يجب أن يحدث أيُّ تغييرٍ في المستقبل، على مستوى الأفراد والشعوب والأنظمة والدول والحضارات.