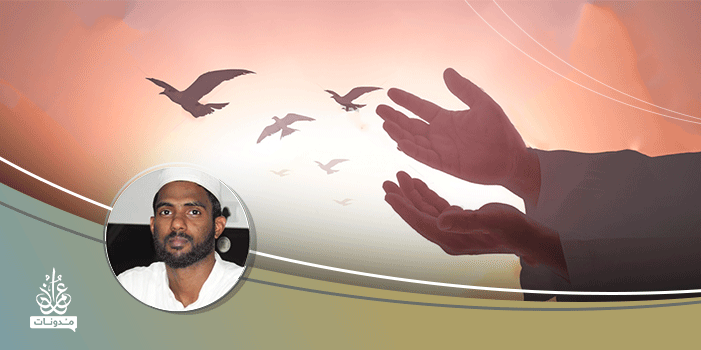سأل أعرابي ابن عباس: من يحاسبنا يوم القيامة؟ فقال: الله. قال نجونا ورب الكعبة. فسأله: لم؟ قال: إن الكريم إذا ملك عفا.
التفاؤل في حياة الإنسان يعد من أهم أسباب النجاة والنجاح، والذي يتخبط في الذكريات المريرة، ويتعبد بل يعربد في الأحزان والآلام، ويقضي مع الساعات الماضية ويرثى لها ويرويها ثقيل الخطى، لا يرتقي إلى رجل يتأمل ويحلم بالصبح القادم الأجمل.
والذي يتمرد دائما ويشاكس فطرته ويشاوس قدره ويثور على الواقع، إنما ينجح في لفت الإنتباه المؤقت الذي سيذهب أدراج الرياح بين عشية وضحاها، والذي لا يفتح فاه إلا لإثارة الفتن الدفينة، أو لإشعال الجمرات الخامدة، ويجبر قلبه على المكوث في مستنقعات الفشل والخيبة، ويصر على العكوف في صوامع الخمول والعزلة، إنما ينساق إلى منحدر وعر لا تُرى غايته، و يضع حياته على مشارف الموت المهين.
خلق المسلم ليكون صانع المعجزات، وكاسر المستحيلات، وموجه الخيرات، لأجل هذا فلا بد له من قوة الإرادة، والعزيمة، والثقة بالنفس، وحسن الظن، والولاء والوفاء، والاصطبار على الإنتظار حتى لحظة الإنتصار. فهو حامل الرسالة الربانية الأخيرة، وعلى عاتقه مسؤولية عظيمة، فكل رجعة تعد إخفاقا فادحا وخطأ كبيرا.
وفي رحاب الأزمات المتراكمة التي تقض مضاجع الأمة، من مشاكل داخلية منهكة، وتدخلات خارجية متربصة، وصراعات دموية، وإنكسارات مضنية نستجد دروس الحديث الشريف التي تملي علينا ضرورة التفاؤل ولزومه ...الرجاء في الغد القادم الأسعد.
ولم يكن الدين ولا قواعده في زمن من الأزمان يبرر السقوط والقنوط، بل جاء ليبثً في الناس وحي الرجاء الصبحي المشرق، ويحثهم على العمل من أجل الجنة ولقاء الله، ويبعث في المظلومين روح الحرية والكرامة، وينفث فيهم فيح الإرادة والحياة.
ولم يسمح الدين لأحد حتى وإن سئم الحياة بالإنتحار والرحيل من الدنيا منكسرا خائبا بل حرًمه، وحرم مقدماته وصرح القرآن ( لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)[سورة البقرة الآية: 195]. وحذر فاعله وجعل النار مثوى للمنتحرين والقاتلين أنفسهم.
فكان أول ما خاض الإسلام معركته ضد الخيبة والقنوط، حتى عاد المستضعفون في الأرض منتصرين، ورفع العبيد الأذلاء لواء الحرية والمساواة والإنصاف، ووهبت غزوة بدر عبراً عميقة تستنهض الهمم الناعسة، وتستنشط المفاصل المسترخية، وأملت للدنيا جمعاء أن إرادة الحياة والحرية أقوى من القدر.
ولم يقف الإسلام عند هذا الحد، بل عرض للعالم محطات مضيئة تحيي الآمال الموؤودة، وترمم القلوب المنهارة، فجاءت غزوة الخندق، لتجعل المسلمين في حيرة وتوتر، وهم في ساعة العسرة، ولم يعرفوا جو المدينة وأهاليها حق المعرفة، ولم يظهر لأعينهم مكيدة المنافقين الذين يطعنونهم من داخلهم، لكن الرسول قام وبعث فيهم روح المقاومة والتحدي، فحفروا جميعا خندقا عميقا، وبطونهم جوعى وشفاههم عطشى، لكن قادهم الأمل الكبير في الإنتصار القادم، ولم يزعجهم تواجد العدو مع عشرة الآلاف بعتادها وعددها على مشارف المدينة، وعقدوا آمالهم على الوحي السماوي الذي يبدد ظلمات الخوف والضعف، ويسقيهم رحيق الإيمان وترياقه، فكانت اللحظات التي تمر بهم قاسية للغاية، وأشباح الحقد طائفة حولهم، وأرواح النفاق ترهق آخر آمالهم وتطفئ من القلوب الضعيفة شرارة الإيمان المتقدة. لكن ماذا حدث؟
انفك الحصار، وفر المشركون والخائنون فرار الخوف والخيبة، واختفى المرجفون في غياهب الغرور التي أردتهم موتى وجرحى، فكان لخيط الأمل الذي انعقدت عليه آمال المسلمين قوة وطاقة فوق مقادير بشرية سافلة.
فكان الأمل في الله كبيرا، وهو القائل:" ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين" (سورة آل عمران الآية: 140).
وفي الجاهلية، إختفت الأساطير والخرافات أمام الأمواج الزاحفة لتعاليم الإسلام، وتصرمت عراه الوثقى لتطير غربان البين إلى البعيد، وتنفى الهامة من على سطح الوجود، وتكسر الأقداح والأزلام، وليهمس النبي عليه الصلاة والسلام في مسمع الزمن" يعجبني الفأل".
ويبشر المستعجلين المتضايقين بقوله (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون).
وشحن القرآن في خفقات المسلمين بطارية الأمل، وعلمهم معنى الصعود والهبوط، ومفهوم الفناء والبقاء، واستراتيجية التحدي وكيمياء السعادة الأبدية، وأنزل لهم الآيات والإرهاصات من الحقائق الكونية، كشروق الشمس وغروبها، وظلام الليل وصبحه، ومن الطبائع البشرية كالمرض والشفاء، والضحك والبكاء، وحرك أفكارهم نحو الآيات التي تهدي للقلوب الواعية دروسا وعبرا عظيمة، هادفا إلى تفعيل عقلية المرء الذي يحبط بالهزيمة لو تعرض له مرض أو مصيبة، وليذكره أن السعادة الأبدية ستلحقك في الآخرة، وأن هذه الدنيا مجرد مسرح للإختبار.
فزراعة الأمل في القلوب الضعيفة عملية معقدة، لا تنجح إلا إذا شخصت كل التحركات النفسية الدقيقة لهذه العملية التي تزيح من الروح الخلايا المعتلة، وتعيد إليها القوة الفطرية التي أودعها الله فيها ليكون الإنسان خليفته وحامل أمانته.
الإسلام دين التفاؤل
ليس في الكون نظرية ولا فلسفة ولا حركة أسهمت في بناء الإنسان المتفائل أكثر من الإسلام، فبداية دعوته انطلقت من التفاؤل والأمل، وهو الذي حدا النبي ليعد أصحابه مدائن كسرى وقيصر وهو خالي الوفاض، وليقول سراقة "كيف لو لبست سوار كسرى"، بينما ظلت الجاهلية تخاف من ظلالها، وتتهرب من وديان الحياة وتقتنع بخلاله الرومان والفرس، وتستهزئ من المسلمين وقائدهم عليه الصلاة والسلام، وهو يدرب عسكرا ضئيل الحجم، وقوي الهمم لطرد الرومان، حتى انبهرت الجاهلية وأربابها لزحف المسلمين الفاتحين بعد أن كسروا قصور كسرى وحطموا أسطورة قيصر.
فما هي الدوافع لهذا الفتح المبين؟
إنه القرآن، ينزل منجما على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يمليه على أصحابه، وهم يحتضنونه آية تلو آية، ويستخرجون من ثناياه طاقة روحية لا تقهر، فعمل في عقولهم القرآن ما لا تعمله أديان صبوح ولا غبوق، وتسرب إلى داخلهم وحي الإرادة الذي لا يفتر، واليقين الذي لا يتزعزع.
وفي حنايا القرآن قصص الأنبياء الذين صبروا على جمر الغضا، ومشوا على ظباة البلايا حفاة ليرافقوا النجاح أخيرا، ويصفق العالم لأبطال البشرية، صناع المعجزات.
فيه قصة نبي الله يوسف عليه السلام أحسن القصص التي تحكي قوة الحلم التي بددت غياهب الظلمات، الحلم الذي إمتد من غيابة الجب إلى الهيبة الملكية.
وفيه قصة إبراهيم الذي وفى، وخرج من نار نمرود بردا وسلاما، وفيه قصة أيوب الذي شكا حزنه إلى الله، وكبح جماح النزوات النفسية الإنسانية.
وفيه قصة صاحب الحوت الذي تمسك بحبل الرجاء الإلهي المتين، ونادى في الظلمات "أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، وإنما حكاها القرآن داخل سورة وأخرى ليصبح المؤمن على وعي بالتاريخ الذي به يستدل في زمن الخيبة والتراجع، ويتمسك به في زمن الإنكسار والتقهقر، وبه يكشف الظلمات وينفك المسلم من قيد الأمنيات التائهة التي لا تعد بغد ولا تفي بعهد.
نحن في زمن الإنتحار فيه وسيلة للنجاة من أثقال الحياة، ورأينا عدة دعاة ومثقفين ينادون إلى حقوق المرء في الموت، وبرروا بأن الموت خيار من خيارات الإنسان التي لا دخل للدين فيها، والإسلام يدعوه إلى واحة الحياة والثورة في وجه الموت، فإذا جاء الموت فإلى تلبية ندائه بأفخم الجواب وأبش الوجه، وأبى الدين الإنحناء الخاضع المطلق، والإنبطاح في حضرة الموت، وجاء الحديث الشريف " الكيس من دان نفسه هواه وأتبع لما بعد الموت"، فإن التفاؤل سمة من سمات الأنبياء وصفوة الخلق، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
وبالمقابل، ماذا يورث التشاؤم في حياة الإنسان غير الضغوطات النفسية التي تستنزف كل الطاقات، وتسد كل الطرقات، وتعتم كل المناظر، وكيف يكسب القلوب من يرى الوجود من خلال السحب الداكنة، ويصف نفسه ذبيح القضاء والقدر، وضحية البيئة والظروف، بينما تمكن له الحياة عشرات الفرص لإسترداد بوصلة السعادة التي فقدها على حين غفلة منه.
فإن من يعيش على رفات التشاؤم ويقتات من خلالته، ويستسقى من زقومه لأشبه بمن استعجل الموت، واستضاف المرض.
فكن متفائلا في حياتك، متأملا في الخيرات التي تحملها الليالي الحبلى، ومتحديا بعباءتك المهابة زوابع الأشواك والحصباء، واصغ إلى كلمات شاعر الخضراء أبو القاسم الشابي لتبعث روحك المنهارة، ويحيى حلمك المتحطم، إذ يقول:
سأظل أمشي رغم ذلك عازفا قيثارتي مترنما بغنائي
أمشي بروح حالم متوهج في ظلمة الآلام والأدواء