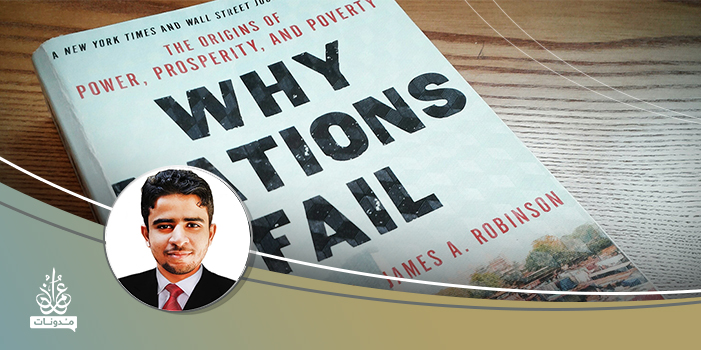عملا المؤلفان Daron Acemoglu/ James Robinson في التحليل والفحص لمدة 15 عاما، واستندا إلى أبحاث ودراسات معمَّقة وتعرفا على أدلة تاريخية في الحضارات: في حضارة المايا، والامبراطورية الرومانية، ومدينة البندقية في القرون الوسطى، والاتحاد السوفييتي، بهدف الوصول إلى نظرية جديدة ومتبصِّرة حول الاقتصاد العالمي والسياسي، وللتعرف على أسراره ومكنوناته الحقيقية والفعلية بنماذج واقعية كيف كانت وماذا صارت، لتكون ذات أهمية للأمم وللمجتمعات وللمؤسسات وللأفراد؛ «لماذا تفشل الأمم؟» هو كتاب مكتوب جيدًا يستند إلى قصة مثيرة ومُقنعة تدور حول نصف الألفية الماضية.
أممٌ تفشل وأمم تنجح... «ما موقع المؤسسات؟»
يأتي عنوان الكتاب لسؤال متغيّر بحسب مضمونه، والتغير يكون من «لماذا تفشل الأمم؟» إلى «لماذا تنجح الأمم؟» وقد بين الكثير من جوانب الفشل وكذلك جوانب النجاح، وبأسلوب قصصي شيق، وطرحه المبسط للأفكار، وتناسق معطياته ونماذجه، ليصل إلى هدفه المنشود إلى حد ما.
يوضح الكتاب أنه على الرغم من عنوانه فلا زال فيه نوع من حوافز التقدم في سرده وتمايز نماذجه ويتساءل عن: لماذا تفشل الأمم؟ وبشقه الآخر: لماذا تنجح الأمم؟
«لماذا تفشل الأمم؟» هي مساهمة ملحة للإجابة على سؤال كلاسيكي عن سبب كون بعض الدول فقيرة والبعض الآخر غني، في شرح مشبع لبعض النماذج الغنية مع نماذج أخرى فقيرة، وشرح أيضا من وجهة رأي المؤلفين لبعض النماذج المذكورة، ولم يتم إشباع إجابة السؤال بشكل شامل وملائم ليكون مرجعا متكاملا يجيب عن كل أسئلة فشل الأمم، مع ذلك فإنه لا زال مرجعا هاما في مجال التنمية المجتمعية والاقتصادية في ظل مؤسسات تواكب الحداثة والتطور وتتبنى مبدأ التقدم والازدهار الذاتي والمجتمعي.
ذكر المؤلفان في الكتاب إجابة السؤال الأساسي بأسئلة رئيسية وبأسئلة فرعية، تم تناولها في سياق مفردات الكتاب بطريقة سهلة للقارئ واضحة المعاني سلسة الأفكار، ولكنه يشوبه أيضا العديد من أوجه القصور ونقص التمثيل، مما يلقي بظلال من الشك على الرسائل الإيجابية لإنشاء مؤسسات أفضل والحد من الفقر.
وما الذي يجعل الدول الفقيرة فقيرة بما يسمى الفشل العام؟ وما الذي يجعل الدول الغنية غنية بما يسمى النجاح العام؟ أي فشل مجتمعات بالكامل ونجاح أخرى بالكامل، أمم تفشل وأمم تنجح، وعند الغوص مليا في دفتي البيان الثري بالسحر القصصي نجد إجابات عن: لماذا مكسيكو من الولايات المتحدة تعد أكثر فقراً؟ ولماذا تختلف أمريكا اللاتينية جوهريا عن أمريكا الشمالية؟ لماذا دخل متوسط الأمريكيين أغنى 40 مرة من متوسط مواطن من سيراليون؟ هل السبب يعود الى المناخ، الجغرافيا، الثقافة، أم جهل القادة المحليين؟ المؤلفان دارون اسيموجلو (وهو تركي أمريكي من مؤسسة مساشوستس للتكنولوجيا والعلوم السياسية)، وجيمس روبنسون (أمريكي من جامعة هارفرد) يرفضان أيا من تلك العوامل ويعتبران السبب الحقيقي الذي يكمن وراء الحلقة المخيفة للفقر والاختلافات الهامة بين الدول هو دور المؤسسات الاقتصادية والسياسية.
والمحور الأساسي في هذا الكتاب يتعلق بالسياسة وتكوين المؤسسات السياسية ، حيث يطرح الكاتبان فرضية أن الدول يمكنها إنجاز الازدهار الاقتصادي فقط ضمن نظام سياسي ديمقراطي شامل، وأن عكس ذلك سيحدث في ظل المؤسسات السياسية غير الديمقراطية، حيث تتراكم الثروات لدى النخبة الحاكمة الضيقة والتي تسعى للمحافظة على سلطتها وبهذا تعاقب بلدها كله ليرزح في فقر دائم.
ويشير الكتاب في أسطره إلى شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية مؤسسات سياسية وإقتصادية من صنع الإنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي، ويذكر أن كوريا الشمالية مبتلية حالياً بمجاعة واسعة النطاق، وسوء تغذية، ومستويات معيشية متدهورة، هذا في حين أن كوريا الجنوبية بلد ديناميكي ومزدهر، بالرغم من أن معظم الصناعات كانت موجودة في الشمال قبل 50 عاماً. ويجادل المؤلفان بأن اقتصاد كوريا الشمالية مركزي التخطيط أعاق الفرص والحوافز لدى مواطنيه، فيما دعمت المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة للجميع في كوريا الجنوبية النمو.
إن الأطروحة الرئيسية للمؤلفين هي أن "الدول تفشل لأن مؤسساتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية تفشل فلا تخلق الحوافز اللازمة للأشخاص من أجل الادخار والاستثمار والابتكار".
وهذه المؤسسات تديرها النخبة وهي المجموعات التي تستغل موارد البلاد لاستخدامها الخاص، تاركة القليل للسكان الكثيرين، وكأنها أشبه بنظام إقطاعي، وعلاوة على ذلك، فإن المؤسسات السياسية الاستخراجية تدعم المؤسسات الاقتصادية من خلال تعزيز النخبة والتي تعتبر قاعدة السلطة ويجادل المؤلفان بأن "المؤسسات الاقتصادية والسياسية الاستخراجية، على الرغم من تفاصيلها تختلف في ظل ظروف مختلفة، وتكون دائمًا أصل الفشل"، علاوة على ذلك، فالسبب الآخر لفشل الأمم عقود الحكم التي نمت في ظلها المؤسسات الاقتصادية والاستخراجية والاستحواذية والتي تحكم بسط نفوذها لاستمرار إحكام سيطرتها على كل منافذ الازدهار، ووفقا للمؤلفين فإن توفير تكافؤ الفرص لجميع مواطني البلد يتيح تحقيق رخاء واسع ونمو مستدام، بالإضافة إلى أنّ المؤسسات الشاملة ترتبط بدورات فاضلة للتنمية، في حين أن الحلقة المفرغة من التنمية هي نموذج للمؤسسات الاستخراجية.
نجاح الدولة.. «بمؤسسات تشمل الجميع»
أما حول مفهوم المؤسسات التي تشمل الجميع بتطورها، يوضح الكتاب أن جوهر الفكرة هي أن المجتمعات الناجحة اقتصاديا، تتدبر أمر تطوير ودعم المؤسسات التي ترعى وتُوجّه المواهب والكفاءات والطاقات لدى مواطنيها، ويشير إلى هذه الشروط بوصفها مؤسسات اقتصادية شاملة للجميع، بالمقارنة مع المؤسسات الاقتصادية الاستخراجية التي تعيق الإنتاجية وتفقدها زخمها وحوافزها من جهة أخرى بغض النظر عن الدول المتبنية للمؤسسات الاستخراجية والتي تكون سببا رئيسيا إن لم يكن وحيدا من أجل ازدهارها.
ويرى المؤلفان أن المجاميع المختلفة من المؤسسات السياسية، تشكّل أيضاً أساس الهياكل الاقتصادية المختلفة، ومن هنا يتضح مجالين: الأول يشمل التوزيع الواسع للثروة والثاني يشمل دولة مركزية فعالة.
يورد المؤلفان لأجل تبني المجال الأول واستيعابه أمثلة من بريطانيا وجنوب إفريقيا، كمدخل لمناقشة المؤسسات السياسية. ويلاحظ أنه في كل حالة، انتهج كلا البلدين نموذجاً استخراجيا، لكن جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، بدأت جهداً طويل الأمد لتوسيع السلطة وخلق مؤسسات شاملة للجميع.
وأورد المؤلفان لأجل تبني المجال الثاني وبيان تأثيره أن الحكومة المركزية الفعالة تزوّد مواطنيها بالحاجات الأساسية، إضافة إلى الحفاظ على النظام العام.
وهذا يثير مثالا كالصومال التي افتقدت إلى حكومة مركزية فعالة على رغم التوزيع الواسع النطاق للسلطة فيها بين مختلف القبائل، والحصيلة أن الصومال تحوّلت إلى دولة فاشلة في التسعينيات لازالت تبعات ذلك مستمرة ومتباينة.
وباستخدام التاريخ كدليل هادٍ، والحديث أن المصالح الواسعة والاستراتيجيات هي عوامل أساسية لتوليد المؤسسات الشاملة للجميع. فخلال ثورة إنكلترا لعام 1688، على سبيل المثال، التحمت قطاعات واسعة من المجتمع في سبيل وقف الحكم الملكي المطلق، وهذا الائتلاف الواسع تواصل وأسفر في نهاية المطاف عن النجاح الاقتصادي المشهود حاليا.
وبهدف المقارنة، مثال انكلترا جنباً إلى جنب مع الثورة البلشفية في روسيا، ويقول بأن هدف إطاحة الملكية الروسية لم يُربط بخطة شاملة، ما أدى في وقت لاحق إلى قيام مؤسسات اقتصادية وسياسية لم تكُن شاملة للجميع.
ويخلص الكتاب في سرده إلى أنه لم يجد دليلاً على أن أي قيم دينية أو ثقافية بعينها يحتمل أن تؤدي أكثر إلى الازدهار الاقتصادي. بدلاً من ذلك، يظهر تحليله للأدلة التاريخية أن المؤسسات التي يصنعها الإنسان تظلل أي نجاح اقتصادي وتكمن في صلبه. وهو يقول، باختصار، أن تطوير المؤسسات الاقتصادية الشاملة للجميع هو العامل الأكثر قدرة على التنبؤ بنجاح الدولة.
الفرق الذي يرسم الاختلاف بين المؤسسات
"إن النجاح الذي يتم السعي له لن يتم الوصول إليه إلا بجهود فكرية وحرية سياسية وعدالة اجتماعية وأمن في العيش والوطن يكون فيه أهل الكفاءة في مكانهم المناسب ولن يتوفر ذلك إلا إذا تم التحرر من القيود داخليا وخارجيا وبتأييد القانون والمجتمع."
إنّ السياسة وتكوين المؤسسات السياسية يأخذان المحور الأساسي في هذا الكتاب، حيث يطرح الكاتبان فرضية أن الدول يمكنها إنجاز الازدهار الاقتصادي فقط ضمن نظام سياسي ديمقراطي شامل، وأن عكس ذلك سيحدث في ظل المؤسسات السياسية غير الديمقراطية، حيث تتراكم الثروات لدى النخبة الحاكمة الضيقة والتي تسعى للمحافظة على سلطتها.
وبدأ الكتاب من خلال دراسة الحالات التاريخية التي على أساسها يوضح النظرية في التغيير المؤسساتي وما يعقبه من نجاح أو فشل للدول. وبدأ بمثال من مدينة نوغالس Nogales على الحدود المكسيكية الأمريكية والتي يفصلها حاجز إلى نصفين. مدينة واحدة، في نفس الوضع الجغرافي، ولها نفس السمات الثقافية ونفس السكان، نفس الأمراض، ولكن أحد الأجزاء أغنى بثلاث مرات من الجزء الآخر وأكثر صحةً وأمناً وأعلى مستوى معيشة، الفرق الجوهري بين الجزئين يرسم اختلاف المؤسسات بينهما.
المؤلفان يؤكدان على أن هذا الاختلاف الكبير على المستوى المحلي له جذوره في البدايات الأولى للاستيطان الاستعماري في شمال وجنوب أمريكا، عندما جاء الإسبان إلى ازتك Aztec والمايا وإلى إمبراطورية الإنكا كان لديهم هدف واحد هو هزيمة السكان المحليين والاستحواذ على ثرواتهم.
إمبراطورية الإنكا التي أبادها الإسبان.
المستعمرون حين أسسوا مستعمرات لهم صمموا نظاما يجبر السكان المحليين ليعملوا لهم ويستخرجوا الموارد بما يثري فقط النخبة الإسبانية الحاكمة الصغيرة، هذا جعل التاج الإسباني في غاية الثراء آنذاك حين تدفقت كميات كبيرة من الذهب والموارد الأخرى إلى داخل البلاد.
وكانت استراتيجية الاستيطان لدى الإنجليز مشابهة للإسبان وهي عملية استخراج الموارد وإجبار السكان المحليين على العمل لصالح النخبة المستوطنة التي تحصل إلى جانب التاج البريطاني على أعظم المنافع.
وهذه الاستراتيجية طُبّقت بنجاح في الهند وافريقيا، لكنها فشلت في أمريكا الشمالية، لأنها كانت متأخرة ولأن شمال أمريكا كان أقل جاذبية، وفيه أقل كمية من الذهب قياسا بأمريكا الجنوبية، أيضا، الأمريكيون الأصليون أبدوا مقاومة كبيرة ولم يسمحوا لأنفسهم ليكونوا عبيداً يعملون لخدمة القادمين الجدد ، كان على المستوطنين العمل بأنفسهم، في البدء هم اُجبروا للعمل من جانب الحكام المستعمرين ولكن هذه الاستراتيجية فشلت بسبب امكانية العمال المكرهين للهرب الى الهند. وبالتالي، كان على المستعمرة أن تخلق مؤسسات مختلفة لتصنع حوافزًا للمستوطنين، ومع المزيد من الحرية الفردية جاءت الحاجة إلى مزيد من الحرية السياسية.
في الواقع، المؤلفان يدّعيان بأن البداية التاريخية لدستور الولايات المتحدة العظيم في 1774 وقتال المستعمرين لأجل الحرية كان تأسيس الجمعية العامة في جيمس تاون عام 1619.
هذه الاختلافات المؤسسية الأولى تجسدت عبر تقليص السلطة السياسية والمبادئ الديمقراطية، والحوافز الاقتصادية التي مهدت الطريق لمختلف مسارات التنمية في الولايات المتحدة ومكسيكو، مولدةً اختلافًا واضحًا بين شطري مدينة نوغالس.
في رأيي، المساهمة الأكثر قيمة للكتاب تتضمن مناهضته للنخبوية ومناهضته للعنصرية ووجهات النظر المناهضة للاستعمار، وكذلك موقف "التمكين" كطريقة للخروج من المؤسسات الاستخراجية، لذلك يدعو إلى "إجبار النخبة على إنشاء المزيد من المؤسسات التعددية".
ويتم تثبيت الاشتباكات داخل النخبة في حين يتم الاعتراف بكفاح الشعوب ضد الاستبداد، ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية في مفهوم "الأسواق الشاملة" ، تحت مظلة شاملة لجميع المؤسسات على الرغم من أن الكتاب لا يحتوي على مواصفات محددة ، إلا أنه من السهل جدًا تتبع ميزاته والفهم الكافي للأسواق الشاملة: "سيادة القانون"، "حقوق الملكية"، "أنظمة براءات الاختراع"، "الاستقرار الاقتصاد الكلي" و"التدمير الخلاق" والحوافز التي تشجع الابتكار. وهذا جيد جدا وأن النسق الذي استُخدم على طول الكتاب بإطاره المذهل كان اتجاها مدهشا في دراسة الحالات، اعتمد التحليل من منظور التكوينات المؤسسية العامة والخاصة.
الاقتصاديات المؤسسية الجديدة
أوضح الكتاب الكيفية التي تؤدي بها المؤسسات السياسية الديمقراطية الفعلية إلى إيجاد مؤسسات اقتصادية ديمقراطية تضع الأساس لتشكيل الثروة والتنمية المستدامة.
ومن المعروف أنّ حزمة السياسات هذه تندرج تحت ما يسمى بالاقتصاديات المؤسسية الجديدة، هذه المدرسة الفكرية تشترك في الحزمة مع الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، والذي يكاد يكون مساويًا تماما للاقتصاد السائد، ودمج فكرة تكافؤ الفرص، ولكن لا تولي اهتماما للموارد غير المتكافئة في نقاط غير متساوية، حتى في ظل الأسواق والمؤسسات الشاملة، من المرجح أن تفيد بالفعل (اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا) مجموعات المجتمع.
وستجد هذه المجموعات أنّه من السهل الإقلاع في ظل ظروف مؤسسية محسّنة، في حين ستظل المجموعات الفقيرة بالموارد تواجه صعوبات شديدة في تحسين سبل عيشها، ومن المحتمل جدًا أن هذا يعرقل السيناريو غير المتماثل أي معنى لتنمية المجتمع ككل، حيث سيتفاقم الخلل في الموارد من قبل التنمية الفاضلة وحلقات مفرغة للتنمية.
من المؤكد أنّ وضع المؤسسات "الحرية للجميع" يعني ضمنيًا نقاطا غير متكافئة لما دونهم، وهذا السيناريو ينطوي على المجتمع، مع بعض الأعضاء أو الكيانات التي تبدأ باليد العليا، والتي من المحتمل أن تنتج الأشياء ذاتها التي يعارضها المؤلفون: النخبوية والسلطوية كجنوب إفريقيا وأداء ما بعد الفصل العنصري هو مثال واحد على مثل هذه النتيجة.
اليوم، عدم المساواة في جنوب أفريقيا هو في الواقع أسوأ من السنوات التي سبقت سقوط نظام الفصل العنصري، بما في ذلك عدم المساواة بين الجماعات العرقية تنفيذ الديمقراطية، وإلغاء العقوبات ضد الفصل العنصري وهناك أيضا إغفال لا مبرر له من العوامل التوضيحية الراسخة بعد المقارنة.
على الرغم من أنه من نافلة القول أنه لا يوجد عمل واحد يمكن أن يفسر كل شيء، وفقًا لذلك قد تتضمن هذه المهمة طريقين رئيسيين في الأول، يوضح المؤلفان ويؤكدان اهتمامهم بالتركيز على عوامل معينة وفي الطريق الثاني، يمكن للمؤلفين استبعاد العوامل غير المحددة من خلال مجموعة من الانتقادات المناسبة، وفي الواقع تمت ممارسة هذه الطرق، ولكن بطريقة مقيدة. كما ذكرنا، فإنها توفر تقييما للجغرافيا، والثقافة، وفرضية الجهل، وفي وقت لاحق من الكتاب، متغيرات نظرية التحديث. بالإضافة إلى ذلك، يعترفون بالأدوار المركزية للاستعمار والعبودية والعنصرية والمفاصل الحرجة (مثل الموت الأسود)، ودورات التنمية الفاضلة والشريرة، والطوارئ و إدراجها من غير تكافئ.
إن انتشار الصناعة والحظ والاحتياجات المتعلقة بالسياق كقوة دافعة غير مرضية إلى حد بعيد، ومع ذلك والأسوأ من ذلك، أنهم لا يأخذون في الاعتبار التدخل الدولي الواضح والحاضر لما بعد الحرب ومنها الحقبة الاستعمارية، والحرب الباردة على وجه الخصوص، و العنصرية المشفرة بالألوان خلال الفترة الزمنية المتاحة.
يتضمن العامل الآخر كيف يرتبط الفقر والثروة بين الدول اليوم أيضًا بالعملية المؤسفة، ولكن في واقع الأمر الكتاب يمثل تمثيلاً ناقصاً لدور الأمم القوية و الكيانات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، والتي تلعب دوراً هاما فيما يجري في العالم، ونوع التطورات المؤسسية التي تم تقييمها ومن المؤكد أن الكتاب (على المستويين الوطني والدولي) يتأثر بالتكوينات المؤسسية الدولية، وهو موضوع يكاد لا يتم التطرق إليه في الكتاب، ومن الأمثلة على ذلك الشركات الوطنية في الموارد الطبيعية القطاع العام في جميع أنحاء أفريقيا. هذه الشركات التي غالبا ما تكون أكبر من البلدان التي تعمل فيها، والتي تستغلها وتكون أيديهم العليا في القضاء الدولي، والوصول إلى المعلومات، والضغط الاقتصادي -بغض النظر عن التطوير المؤسسي للبلد وقطاع الأعمال-. بطريقة مماثلة، بغض النظر عن زيمبابوي وهناك دول تصنف على أنها مؤسسات شاملة تحمل بشكل منهجي التدخلات الاستخراجية في الدول الأخرى. لكي نكون منصفين ، ذكر مثال واحد في الكتاب: تدخل العراق في عام 2003. لسوء الحظ ، لم يتم اتخاذ هذه النقطة لإدراجها في المباراة النهائية ومن المرجح أن تؤدي هذه الاضطرابات الدولية إلى عرقلة أو عكس التطورات المؤسسية.
إن البحث عن أصحاب المصلحة الدوليين يستغل اختلالات القوة الحالية التي لا تعتمد على المؤسسات في الإعدادات وحدها. ويجادل المؤلفان بأنه من الصعب تتبع العوامل الناشئة للمؤسسات الشاملة، مع الاستمرار في ذلك وربما كانت ثورة إنجلترا ا لعام 1688 منعطفًا حرجًا أساسيًا لبداية العصر الحديث على الرغم من أن البيانين مقبولان، فمن المعقول حسبهما أن مؤسسات الغرب شاملة للجميع.
وتم التطرق إلى التغيير الضروري بشكل غير مباشر في الكتاب، حيث إن نجاح الثورة في إنجلترا يعزى إلى "صعود التجارة الأطلسية التي أغنت وشجّعت التجار المعارضين للتاج". الكل في الكل، على الرغم من أن هدف المؤلفين هو تأطير التطورات المقارنة بعدسة مؤسسية، واستبعاد ممكن وأن منشئو فكر بناء المؤسسات يزيد من قلة تمثيل السرد وتأثيره.
وكذلك دمج هذا المركب الثنائي من المؤسسات الديمقراطية السياسية والاقتصادية يضع الحوافز المطلوبة لتطور المجتمع، لو أنّ الناس يرون ثرواتهم تُصادر سوف يفتقدون الحافز لخلقها أو المحافظة عليها. هم سوف يفشلون في الابتكار وانجاز التقدم، الناس يحتاجون إلى عدد أساسي من المؤسسات لتقليل حالة عدم التأكد والحفاظ على الاستقرار.
هذه المجموعة الأساسية من المؤسسات الاقتصادية الديمقراطية تتضمن حماية حقوق الملكية، حكم القانون، الخدمات العامة وحرية التعاقد. الدولة يتم الوثوق بها في توفير كل تلك المسائل، فدورها هو فرض القانون والنظام وفرض العقود ومنع السرقات والاحتيال. وعندما تفشل الدولة في توفير مثل هذه المؤسسات فإنها تصبح استغلالية، حيث يصبح هدفها الرئيسي إشباع حاجات النخبة الحاكمة الصغيرة (سواء كانت: حاكم البلاد أو مجموعة الحكام أو جماعات المصالح السائدة).
يصوغ المؤلفان فرضيتهما الأساسية وهي أن وجود مؤسسات اقتصادية قوية توجّه الحوافز نحو خلق الثروة يمكن إنجازها فقط عبر نظام سياسي أكثر تحرراً وأكثر عدالة .
إن التحرر السياسي وتوزيع السلطة السياسية العادلة والواسعة في المجتمع هما العنصر الأساسي الذي يقرر مدى نجاح أو فشل الأمم ومدى بقائها وتغيرها.
إن نتيجة هذه الأطروحة المميزة والعميقة المنبثقة من واقع السنوات والتاريخ الفعلي والحقيقي أنتجت عملا جبارا يكاد يصل بمحتواه إلى الإجابة الشافية التي تشبع رغبة القراء وتعالج أزمة الأمم.
فرضية «الجهل» وعلاقتها بصناع القرار
يشير المؤلفان إلى هذه الأحداث كمحطات حاسمة في التاريخ استغلت الاختلافات المؤسسية الصغيرة وقادت الى تشعب مسارات التنمية للأمم، وإن أحد الأمثلة الهامة لتلك المحطات الحاسمة التي ساهمت في الافتراق بين أوروبا الغربية والشرقية كان ما سمي بالطاعون الأسود في القرن الرابع عشر وهو مختلف عن النماذج الاستيطانية في العديد من الدول، أكثرها وضوحا هو في جنوب وشمال أمريكا.
وكذلك النقطة حول السوابق الاستخراجية المحتملة للمؤسسات الجامعة الصالحة أيضًا على المستوى الوطني و يصنف المؤلفين، على سبيل المثال ، الولايات المتحدة على أنها تضم مؤسسات جامعة: "في النهاية"، وأن المؤسسات الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة ناتجة عن المؤسسات السياسية التي ظهرت تدريجيًا.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني أيضا من الفقر على نطاق واسع، وعدم المساواة الجسيمة، والتمييز الهيكلي وغيرها من المؤسسات الفقيرة، وفي حين استيعاب عدد قليل من النخب الأثرياء للغاية، والتي هي قادرة على التأثير في القرارات السياسية لصالحهم.
ويشتمل الكتاب على استخدام متناقض لفرضية الجهل بأنه "... إذا كان الجهل هو المشكلة، فإن القادة ذوي النوايا الحسنة سيتعلمون بسرعة، إنّ أنواع السياسات زادت دخلهم ورفاهيتهم، وسوف تنجذب نحو تلك السياسات؛ في حين أن موقفهم هو الذي خلق الفقر.." الدول الفقيرة فقيرة لأن أولئك الذين لديهم السلطة يتخذون خيارات خلق الفقر وفي وقت لاحق من هذا الكتاب، استنتج المؤلفين أن برامج مجتمع المانحين و صندوق النقد الدولي "... قائم على فهم غير صحيح لما يسبب الفقر".
من خلال التصريح بذلك، فإنهما ضمنيًا يعترفان بوجود الجهل، من المعقول التمييز بين صنع القرار على الصعيدين الدولي والوطني، على غرار المزايا الداخلية والخارجية. ومن الممكن فعلا تتبع هذا المنطق في الكتاب، وإن كان غير مقصود على ما يبدو: "فرضية الجهل ليست مرتبطة بصناع القرار في البلدان الأكثر فقراً، ولكن للمؤسسات الموجودة في الدول الغنية"، هذا التمييز سطحيّ والأهم أنه يتناقض مع موقفهم الصريح. على سبيل المثال، تصويرهم لمجتمع المانحين وصندوق النقد الدولي على أنه ساذج إلى حد ما ، ويمثله البيان: "الدول الغربية تشعر بالذنب والقلق… والمساعدات الخارجية تجعلهم يشعرون بأن هناك شيئا يتم القيام به..". وهناك غيرها، أكثر بكثير وكذلك المهام ، والدوافع لتوفير المساعدات، على سبيل المثال: التأثير السياسي والتجاري، وهناك أيضًا سبب آخر للتشكيك في رفض المؤلفين للجهل كفرضية على الرغم من أنه من السهل مشاركة هذا الفصل على المستوى الكلي، حيث القرارات وإجراء الاتجاه العام وتوزيع الاستثمارات، وعمليات صنع القرار والمستويات التي قد تنطوي بسهولة المعرفة المحدودة والمشاركة، على مستوى ملموس أكثر، و من المحتمل أن صناع القرار وأعضاء طاقمهم لا يملكون المهارات اللازمة لتنفيذ البرامج المناسبة، لا سيما في أوقات الأزمات، وحشد التأييد العدواني، ونقص الموظفين وتضليل المعلومات والحملات.
تقويض مفاهيم شائعة عن التخلف.. «تنظيم المؤسسات» أولا.
في سعي الكاتبين لتوضيح دور السياسة في التنمية، يتعاملان مع نظريات أخرى حاولت توضيح ضعف النمو والتخلف وهي:
- الوضع الثقافي حيث يُلام السكان لعدم قيامهم بالأعمال الشاقة (غير منتجين) نظرا لقيودهم الثقافية والدينية والأخلاقية (المثال الشهير هنا هو نظرية الأخلاق البروتستانتية لماكس ويبر).
- الموقع الجغرافي للدولة (الأقطار في المنطقة شبه الاستوائية)، التي تعاني من مناخ مضطرب و أراضي قاحلة وأمراض استوائية.
- جهل النخب الحاكمة في البلاد، يعني أنها لو امتلكت خبرة اقتصادية جيدة لربما كانت قادرة على الخروج من الفقر وهما أيضا يتعاملان مع نموذج الاقتصاد المزدوج الذي اعتُبر مسؤولا عن تخلف إفريقيا بسبب التعايش بين قطاعين ضمن اقتصاد واحد وهو ما جعل الحراك الاجتماعي بينهما مستحيلا وغير مناسب.
وكل هذه الحجج وجدها المؤلفان خاطئة، وحكم النخب الضيقة التي تنظم المجتمع لأجل مصالحها الخاصة هو شائع في كل الدول التي سلكت طريقها للفقر. الفروقات بين شطري نوغاليس والكوريتين وألمانيا الشرقية والغربية لا يمكن توضيحها بالجغرافية أو الثقافة أو الأمراض أو الجهل، إنه من الممكن توضيحها فقط بمختلف المؤسسات السياسية التي أدت إلى مختلف المحصلات الاقتصادية.
وكما في نموذج الاقتصاد المزدوج في إفريقيا، كان مفتعلاً من جانب النخبة الحاكمة البيضاء التي حافظت على مؤسسات اقتصادية استغلالية.
المشكلة ليست في أن البلد الفقير يبقى فقيراً بسبب الاستغلال الخارجي أو (الداخلي) أو بسبب الجهل الاقتصادي أو كسل السكان! إن السبب يكمن في دور السياسة، وكيفية تنظيم المؤسسات الاقتصادية والسياسية للبلد من جانب النخب الحاكمة.
وإذا كانت المؤسسات السياسية منظّمة كاستغلالية ومركّزة بيد النخب الضيقة، عندئذ ستعمل المؤسسات الاقتصادية فقط لأغراض النخب الحاكمة مولدة أعظم الثروات لها. ولو أن تلك المؤسسات نُظّمت كمؤسسات ديمقراطية، والسلطة موزعة بين العديد بدلاً من تركيزها بيد القلة، عندئذ فإنّ هذه البيئة المؤسسية سوف تخلق حوافزًا لمؤسسات اقتصادية ديمقراطية، حيث الابتكار والتحطيم البناء سيضمنان خلق تنمية ونمو اقتصادي دائم.
لكي تصبح الأمة غنية لا بد من الإطاحة بالنخب الحاكمة وتوزيع السلطة والحقوق السياسية بالتساوي ضمن المجتمع. الحكومة عليها أن تصبح مسؤولة ومتجاوبة مع شعبها الذي يستطيع استخدام هذا الأمان والاستقرار لإحداث التقدم في الفرص الاقتصادية المتوفرة له ويسعى نحو تنمية يستفيد منها إلى أجياله المتعاقبة.
ولكن يعترف المؤلفان بأنّ النمو يمكن تحقيقه عبر عدد من المؤسسات السياسية الاستغلالية، النخب يمكنها ببساطة إعادة توزيع الموارد نحو نشاطات مؤقتة عالية الإنتاج تضعها تحت سيطرتها (مثلا: من الزراعة إلى الصناعة)، ولكن المشكلة هي أن هذا النمو غير دائم في المدى البعيد. عندما يُستنزف الاقتصاد، ذلك ينعكس على النمو السريع والبلد سوف يتعرض أولا إلى كارثة اقتصادية ثم لاحقا إلى كارثة سياسية، مثال النمو السريع لروسيا السوفيتية يوضح هذه النقطة، هو لم يأت بفعل الابتكار وإنما بفعل سيطرة الدولة، وعندما استُنزفت مؤسسات النمو لم يأت شيء ليحل محلها.
يتكهن المؤلفان بأن نفس الشيء سيحصل في الصين، حتى لو كانت الصين مختلفة عن روسيا السوفيتية، كونها توظف مؤسسات اقتصادية ديمقراطية، فإن النخبة السياسية لا تزال تمنع التحطيم البناء ، هما يذكران مثالاً عن مبدع صيني أراد المنافسة مع كبريات شركات الستيل المملوكة للدولة وغير الفعالة حيث انتهى به الأمر إلى السجن، وهذا مناخ الصين المضاد للابتكار، الرقابة على ميديا والنمو التكنولوجي المعتمد على تبنّي التكنولوجيا بدلاً من الابتكار، كلها تشير الى نظام سياسي استغلالي لا يمكن فيه الحفاظ على النمو، و الصين يمكنها التغلب على هذه المشكلة وبلوغ النمو الدائم لو أنها نجحت في المباشرة بإصلاح سياسي يُدخل المزيد من الحريات الفردية والسياسية، وحتى ذلك الحين هي ستبقى محكوماً عليها بتكرار السيناريو السوفيتي.
النظام السلطويّ.. «خلق العوائق والحدّ من الابتكار»
وأثناء التصفح يوجد في الكتاب العديد من الأمثلة التاريخية الداعمة للفرضية المركزية للمؤلفين، بعد تحديد الإطار الرئيسي للتحليل في الفصول الأولى، يأخذ القارئ في رحلة عبر التاريخ مبرزاً عدد من القصص التاريخية الشهيرة في النجاح والفشل، هذا يعطي القارئ فرصة ليرى الكيفية التي تلعب بها السياسة دوراً هاماً في تطوير المجتمع وتنميته وازدهاره.
نحن نرى نفس النموذج التاريخي يتكرر حدوثه في البندقية وفي روما القديمة وإثيوبيا ومدينة مايان وفي روسيا السوفيتية والكونغو وفي إسبانيا القرن الثامن عشر، الخصائص المشتركة التي قادت تلك الدول للفشل كانت عدم ديمقراطية مؤسساتها السياسية، وحتى لو أنها حققت نموا سريعا وقصيراً (مثل الملكيات المطلقة وروسيا السوفيتية)، فذلك النمو كان مؤقتا وغير مستقر ما لم يسلك مسار الديمقراطية. حينما امتلكت روما القديمة والبندقية وولايات مايانا مؤسسات ديمقراطية وإن كانت جزئية، أدى ذلك إلى خلق حوافز ملائمة للنمو، قادت إلى نجاح تلك الدول. لكنها عندما تحولت نحو الحكم السلطوي واحتكار الحكم من قبل النخبة، برزت الصراعات وبدأ الانحدار في مجتمعاتها. العمل المؤسسي استُبدل بالسلطوي وهو ما أدى إلى نتيجة معاكسة تتمثل بفقدان التنمية وإحكام السيطرة عليها.
وفي انجلترا حدث شيء معاكس، بينما كان القمع في دول أخرى هو النوع السائد للنظام الاجتماعي، ففيها كانت الدعوات المطالبة بمزيد من حقوق الملكية والاقتراع السياسي والتي وضعت الأساس للازدهار والنمو الدائم.
"التحطيم البناء" والابتكارات التكنولوجية جعلت الناس أكثر ثراءً وقادت إلى توزيع جديد للثروة وإلى ما هو أكثر أهمية، التوزيع الجديد للسلطة بالمجتمع. النخب التي تخشى من فقدان امتيازاتها عارضت هذه العملية. شعرت بالتهديد وخلقت عوائقا للابتكار. ولكن في انجلترا، وبسبب الصراع السياسي، تراكمت ثروة التجار والمصنعين في هزيمة هذه المعارضة وتقييد قوة الطبقة الحاكمة ليشكل ذلك بداية عصر تاريخي جديد.
هذا بالضبط يفسر لماذا بدأت الثورة الصناعية في انجلترا، وليس في أي مكان آخر في العالم، الثورة الصناعية حدثت بعد عمليات الثورة التي كانت الأهمية الكبيرة للتحالف الواسع الممثل للناس هو الذي قاد للنجاح، ولو لم يكن هناك مثل هذا التحالف الواسع، فإن إحدى النخب سيكون بمقدورها ببساطة التغلب على الأخرى والاستمرار في المؤسسات اللاديمقراطية (كما حدث بإيجاز خلال ديكتاتورية اوليفر كرومويل)، التغيير السياسي غير المرتد والتحول نحو المؤسسة حول الحوافز الاقتصادية في المجتمع وخلق ازدهاراً وثروات هائلة لتصبح متقدمة فاعلة.
ولكن لم تتبع كل الدول هذا الشكل من التنمية السريعة، ولم تنل كلها فوائد الثورة الصناعية، البعض لم ينل ذلك لوقت طويل، بسبب هذه اللحظات التاريخية الحاسمة.
يوضح المؤلفان سبب بقاء جميع الدول التي خرجت محطمة من الامبراطورية العثمانية لتبقى فقيرة نسبيا (شريطة ألا تكون مصدرة للبترول)، وهنا أختلف مع المؤلفين حول ما يسمونه بالامبراطورية العثمانية التي ادعيا أنها بدلا من تبنّيها التغيير شعرت بالتهديد منه وقامت بمعاقبة رعاياها بـ 200 سنة أخرى من الفقر والاستغلال ولم تكن المعارضة للنخبة في الامبراطورية العثمانية بنفس قوة المعارضة في انجلترا، وهو ما يفسر عدم ظهور أي مؤسسات ديمقراطية هناك.
وهنا يجادل المؤلفان لفرض نظريتهما ولم يتطرقا إلى المؤامرات التي كانت تدار في داخل الخلافة العثمانية وخارجها لمنع أي تماسك لهذه الإمبراطورية العظيمة التي سعت جاهدة للحفاظ على الأراضي الإسلامية وتماسك المسلمين والسعي نحو تقدمهم ونموهم في شتى المجالات، ويردف المؤلفان أن نفس الشيء ينطبق على العديد من الدول في ذلك الوقت بما في ذلك إسبانيا وروسيا أو الصين و المجر النمساوية.
يشيران إلى أنّ المتسلطين على السياسة إن أحسوا بالتهديد من التكنولوجيا والابتكار، منعوا وجودها وتطورها، ليستمر تواجدهم وبذلك يمنعون بقوة خلق الثروة والازدهار والتنمية والابتكار.
ومما يخلصان إليه من خلال توضيح حلقات التقدم بنوعيها المفرغة والتصاعدية، متى ما وجدت هناك مؤسسات ديمقراطية، ستخلق الدورات التصاعدية السليمة تغذية إيجابية تمنع النخبة من التغلب عليها. انها سوف تضمن أن المؤسسات الديمقراطية تتمدد وتصبح متواصلة. ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الاستغلالية ستؤدي الدورات المخيفة الفارغة الى خلق تغذية سلبية تمنع التقدم.
زوال الحاجة إلى الاستغلال.. «بحُكم القانون»
لكي تعمل الدورة التصاعدية فإن أول شرط مسبق لها هو أن تكون هناك تعددية تشكل حكم القانون وتقود إلى مزيد من المؤسسات الاقتصادية الديمقراطية، والتي ستزيل الحاجة إلى الاستغلال طالما أن أولئك الذين في الحكم سوف يحصلون على القليل ويخسرون الكثير لو أنهم اشتركوا في القمع وكبحوا الديمقراطية، أخيراً، هما أيضا يعترفان بأهمية الإعلام الحر في تزويد المعلومات عندما يحصل تهديد للمؤسسات الديمقراطية.
الدورات التصاعدية توضح كيف أصبحت إصلاحات النظام السياسي في بريطانيا وأمريكا لا يمكن إعادتها إلى الوراء، طالما أن أولئك الذين في الحكم أدركوا أن أي انحراف ممكن سوف يشكل خطورة لموقعهم. الأمثلة عن بريطانيا الموحدة وخطواتها البطيئة والمشروطة نحو الديمقراطية حيث فيها طالب الناس تدريجيا واستلموا تدريجيا المزيد من الحقوق، أو إجراءات نزع الثقة من الاحتكاريين في أمريكا في بداية القرن العشرين، أو المحاولات الفاشلة للرئيس روزفلت في تقليص قوة المحكمة الأمريكية العليا.
إن التعددية وحكم القانون كانا شرطان حاسمان قادا إلى تحديد القوة السياسية التي جعلت الدورة التصاعدية ممكنة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهذا كان بالضبط لماذا فشل فوجوميري رئيس بيرو و شافيز رئيس فنزويلا أو رئيس الأرجنتين، هم فشلوا في خلق مؤسسات لتحديد السلطة السياسية.
وهذه الأنظمة خلقت مؤسسات استغلالية وخلقت دورات مخيفة فيها، لم يعد للنخب الحاكمة أي قيود على السلطة وامتلكت حوافز كبيرة للابتزاز وانتزاع الثروات. حتى لو كان يتوجب إسقاط هذه النخب بالثورة، فإن القانون الحديدي للاوليجارتيه كان يعني ببساطة أن تحل نخبة جديدة محل القديمة وتستمر في الاستغلال وربما أسوأ من الأخيرة. وهذا يعكس نوعا ما شك الكاتبين بقدرة الربيع العربي على إنتاج التحول الضروري نحو الديمقراطية.
مرة أخرى الكاتبان يحاولان إقناع القارئ في آلية التغذية السالبة وبالقانون الحديدي الأوليغارشية من خلال العديد من الحالات التي تتراوح من سيراليون وغواتيمالا وإثيوبيا وزيمبابوي واوزبكستان وكولومبيا والأرجنتين ومصر وحتى العبودية في جنوب أمريكا، غير أن الدورة المخيفة في جنوب الولايات المتحدة كان من السهل خرقها بسبب وجود المؤسسات الديمقراطية على المستوى الفيدرالي وأن حركة الحقوق المدنية ولّدت المساواة في الجنوب ومهدت الطريق للنمو الاقتصادي له.
ولم يظهر المؤلفان جوابا تصيغه وصفة للتنمية، طالما لا يوجد مثل تلك، وكان ارتكاز نظريتهما على أحداث حاسمة ومسارات تاريخية محددة أفقدها القوة التنبؤية طالما من الصعب القول أي الدول تستطيع كسر الحلقة بسرعة، إن النظرية تستطيع القول أي الدول يمكن أن تبقى فقيرة لوقت طويل لكنها لا تستطيع الإجابة على السؤال عما سيحصل بعد الأحداث مثل الربيع العربي. عدة عوامل سوف تقرر ما إذا كانت الدول العربية تباشر مسار تدريجي للديمقراطية أم أن القانون الحديدي الاوليجارتي هو الذي سيسود معدما حقيقة تلك النظرية.
إن الازدهار لا يمكن هندسته عبر المؤسسات الدولية بوصفة للإصلاح أو بالمساعدات الخارجية فقط، بل يجب أن يأتي من الناس ومن مشاركتهم في العملية السياسية والاقتصادية أفرادا ومؤسسات حالما يتشكل ائتلاف واسع سيصبح بإمكان المؤسسات الديمقراطية الاستمرار، والإصلاح السياسي يصبح غير قابل للارتداد.
ربما يستنتج أحد أنه بالاعتماد على هذا الاتجاه فإن المؤسسات الاقتصادية والسياسية الديمقراطية تتطور تلقائيا بينما المؤسسات الاستغلالية تُفرض قسرا من الخارج، الطريق إلى التقدم هكذا هو دائما يتحقق عبر المزيد من الحريات الاقتصادية والسياسية الفردية.
الجزء الوحيد الذي لم يتحدث عنه المؤلفان بالتفصيل هو ما سيحدث بعد تحقق الحريات السياسية والاقتصادية، عندما تحاول نخب محددة أو جماعات نفعية منظمة الحصول على الدعم السياسي لتحقيق أهدافها الذاتية، والجواب من الكتاب ربما يكون أن هذا السيناريو يقع خارج التعريف العام للمؤسسات السياسية الديمقراطية، حيث أن ميديا يتم الإمساك بها جزئيا وحيث أن المصالح الذاتية الضيقة يمكنها أن تختصر النظام لكي تستخلص منافعا معينة. ومن هنا فإن إطارهما يمكن تمديده ولكن حجم الكتاب الكبير سلفا ومدى نطاقه يمنع المؤلفين من التوغل عميقا في الموضوع.
وأيضاً هناك شيءٌ واحد يعتبرُ الأفضل حتى يكون الكتاب ذا فائدة عملية وهو برغم الدراسة والتحليل العميق الذي أجراه مؤلفي الكتاب والمدة الزمنية الطويلة التي أخذت منهما جهدا كبيرا ليثمر عنه تلك الأفكار التي استجدت في العقول، إن المأخذ الوحيد هو عدم وضع آلية عملية يمكن من خلالها تغيير الواقع الفعلي بدور مهم نحو ما أنتجه الكتاب في طياته وأفكاره، فيكون إنجازا كبيرا لهذا العصر ونظاما لكل الأمم التي تسعى نحو الأفضل لسد الحاجة وتعميم الحجة لذلك.
وفي الختام، تعد قراءة الكتاب جيدة ونافعة، سهلة الإدراك حيث يعرض رواية مقنعة عن الاقتصاد العالمي الحديث وعن التاريخ ويعد فكرة ناجحة في تحقيق هدفها المتمثل في الإجابة على السؤال: لماذا تفشل الأمم؟