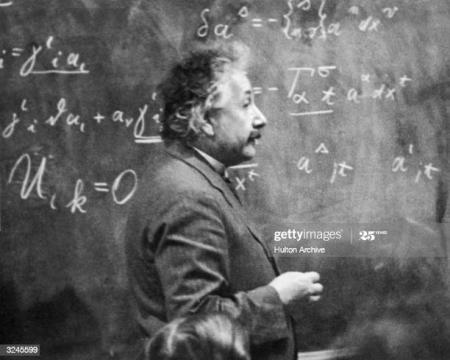في الوقت الذي كان فيه السلطان العثماني بايزيد خان الأول يتأهب لغزو أوروبا بحملة قوامها نصف مليون جندي وذلك مع فجر القرن الخامس عشر الميلادي، تحركت عاصفة عسكرية أشد هولاً، ومن نفس العرق التركي والدين الإسلامي، وبسبب تاريخي تافه، تحركت مزمجرة من الشرق يقودها عسكري تتري مرعب خلَّد اسمه في التاريخ بكل الفظاعات الممكنة تيمو الأعرج (تيمورلنك)، ليحطم الطموحات العثمانية الجنينية للسيطرة على أوربا، في معركة أنقرة التي قررت مصير أوربا في 20 تموز يوليو عام 1402م الموافق 19 ذي الحجة من عام 804 هجري، وليوقف المد الإسلامي، ولينقذ جنين الحضارة الغربية الذي كان قد تشكل آنذاك في أحشاء الزمن، بعد أن تلقح من نطف الحضارة الإسلامية، التي كانت تودع التاريخ وتتوج ختامها بتألق الشمعة الأخير بفكر سنني متماسك هو فكر ابن خلدون، الذي أرَّخ لهذه المرحلة بمقابلة شخصية مع تيمورلنك الذي واصل تحطيم الشرق الأدنى، ليحط الرحال في دمشق أخيراً.
هذا الارتطام الأعمى بين قوتين إسلاميتين لتنجو وتولد حضارة غير إسلامية هل هو مجرد مصادفة عبثية؟ أم عمى تاريخي؟ لنتأمل الواقعة تحت مبضع التاريخ!
عندما بدأت البحث شعرت أن علي استخدام أدوات معرفية للاكتشاف، أو لنقل منهجاً ينظم عملية اكتشاف التراكم المعرفي الذي حصل في الغرب، والذي قصَّر عنه العالم الإسلامي، والذي يعاني من وطأته حتى اليوم، وهذا القصور المعرفي ليس في الفيزياء والكيمياء والبايولوجيا والكوسمولوجيا فحسب؛ بل هو أيضاً في الإدارة والاقتصاد والسياسة والثقافة والفن، ولنقل هو قصور حضاري مريع، كما عنون المفكر الجزائري مالك بن نبي سلسلة 18 كتابا بعنوان سلسلة مشكلات الحضارة. وأمامنا عمليتان كل منهما أصعب من الأخرى، كمثل الطالب في المرحلة الابتدائية الذي تطلب منه أن يصل إلى المستوى الجامعي، وليس ذلك فحسب بل أن يكون طالباً متفوقاً له دور ريادي في فصله، وهذه هي مشكلة المشاكل في العالم الإسلامي والتي تشكل منخس التحدي الرهيب؟!
الحوادث التاريخية لا يمكن أن تفهم معلقة في الهواء، فهناك علاقة جدلية بين الأحداث، والجدلية أي سنة الترابط هو قانون إلهي في هذا الوجود وليس اختراعاً من ملحدين، الترابط والتناسق بين الليل والنهار، الحزن والفرح، الانفعال والفعل.. (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48)) [سورة النجم] وهكذا فكل حدث هو في علاقة جدلية بما قبله وبما بعده، هو سبب لما سيأتي بعده وهو بنفس الوقت نتيجة لما قبله.
والأحداث العظيمة هي تراكمات لإنجازات صغيرة، والانتصار الكبير هو تتويج للجهود الصغيرة المتراكمة عبر الزمن، بل إن الإنسان إذا أفرغته في صورة معادلة فإنه يساوي: (الإنسان في لحظة = محصلة تراكمية بطيئة للحظات الجهد الواعي المتراكمة عبر وحدات الزمن قبل لحظة القياس). وهكذا فالكون في حركة ونمو (يزيد في الخلق ما يشاء)، والوجود في حالة صيرورة وتدفق، وكل شيء يتغير سواه سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وليس كمثله شيء وهو السميع القدير. (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)، والإنسان في كل لحظة هو غيره بعد اللحظة التي سبقت بل والوجود حسب قانون هرقليطس الثالث. ويخطئ من يظن أن هناك توقف في نمو الإنسان حتى مع تقدم العمر، فالدماغ الإنساني تركيب رهيب مكون من مائة مليار (100000000000 = 1 أمامها أحد عشر صفرا) من الخلايا العصبية في قشر المخ، وكل خلية في أقل التقديرات مرتبطة بألف إلى عشرة آلاف وحدة ارتباط، مع بقية الخلايا العصبية، بل نجدها مائتي ألف ارتباط في خلايا بوركينج في المخيخ، المسؤول عن تناسق الحركات والتوازن، مما يجعل الدماغ الإنساني أكبر من الكون المعروف (جزئيات الكون هي مائة مرفوعة إلى قوة 83 إلى حواف الجوجول) ومنه اشتقت مؤسسة جوجول المعروفة اسمها أي هي تملك كل المعرفة الإنسانية بما فيها خرائط الأرض، وبالتالي فليس هناك حد لنمو وكمال الإنسان إذا تصورنا كل كسب معرفي شجرة ارتباطات عصبية، والإبداع توليدات معرفية جديدة.
كما أنه ليس هناك قعر لهبوط الإنسان باعتبار تميز الإنسان وتفوقه بدماغه وليس بمخالبه، فالفيل أعظم حجماً من الإنسان، والثور أشد بأساً، والكلب والأرنب أشد جرياً، والنمر أعظم بطشاً، والعصفور أمرس في السفاد، والقط يقتات من الطعام بمتعة ما هو بمثابة السم من جلد الفئران وحراشف الصراصير وأقدام العناكب
(لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ) ولنتأمل تعبيرات أحسن وتقويم وما يعاكسه من أسفل وسافلين بصيغة النكرة؛ فهي قوة مرفوعة إلى نفس قوتها، حسب مصطلحات الرياضيات وهذا يعني لاحدود للهبوط أو الارتفاع.
وحتى يمكن فهم ما (حدث في العالم) حتى لا نكون خارج التاريخ والجغرافيا فلابد من اتباع منهج الكشف في (حفريات المعرفة) كما في حفريات طبقات الأرض، والتعرف على (إضافات المعرفة الإنسانية) أو حسب القرآن منهج السير في الأرض لمعرفة التطورات التي حدثت (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق).
فكرة القانون (السنة)
اكتشف ابن خلدون شيئاً هائلاً قديماً حينما وضع يده على فكرة القانون أو السنة بتتبع (كيفية خلق الأشياء). وهكذا توصل إلى هذه الأشياء الرائعة والمتألقة والتي سماها (الحِكَم المحجوبة والقريبة) أو (تلك التي لم يتفطن لها إلا الآحاد من الخليقة) مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما كشف للآحاد يوماً، يصبح بعد حين من البديهيات للملايين؟!
وهكذا وضع ابن خلدون مثلاً يده على قانون عمر الدول وحدَّده في مائة وعشرين عاماً، على اعتبار مروره في ثلاث أجيال وأن كل جيل هو أربعين سنة، والجميل إلى حد التألق هو ذلك المزج المقدس بين هذه المفاهيم التي وصل إليها وبين النص القرآني، فهو قد انقدح له معنى الجيل المحدد بأربعين سنة من تيه بني إسرائيل المحدد في أربعين سنة من قصة موسى وهارون مع الجموع التي هربت معه من استبداد فرعون.
فكرة القانون أو السنة بقدر ما هي طاغية ومسيطرة في النص القرآني، بقدر ماهي غائبة في وعي المسلمين التاريخي، وبقدر ما يؤكد القرآن على أنه لن يجري المعجزات، فإن المسلمين وقعوا في مطب الخلاب والسحري والمعجز، وبقدر ما وجه القرآن النظر لفهم الواقع المعقد، والكون المعجز ضمن مفهوم الآية، بقدر ما سيطر على مخيال المسلمين الأسطورة والمستحيل.
وبذا انفصل العالم الإسلامي عن الواقع وافترسته الخرافة، وفقد الروح العلمية، وعشق الحقيقة، واكتشاف الكون ورؤية آيات الله التي لا نهاية لها ولا حدود.
والقرآن حينما أراد بناء العقل السنني، والروح الباحثة، والشوق المعرفي، والتراكم العلمي فإنه لم يتوجه إلى قوانين الفيزيولوجيا وإفراز الهورمونات، ولا إلى السنن الفيزيائية وتمدد المعادن بالحرارة وضغط السوائل وبناء الذرة ( مع كل احترامه وتزكيته لمعرفة كل خفايا الكون)، ولكن كان يتوجه لمعرفة القوانين التي تنتظم حركة النفس وصيرورة المجتمعات، وقيام الدول وسقوط الحضارات وكل الآيات التي تشير إلى مفهوم (سنة الله) تأتي إما أثناء الكشف عن ميكانيزم نفسي، أو حركة المجتمع وإصابته بأمراض تماماً مثل إصابة البدن بالأمراض. (وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا * سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا)
إن التوجه الذي مشت فيه الحضارة الغربية حتى الآن هو كشف الحقيقة خارج الإنسان، أي معرفة الوجود الخارجي، وهذا توجه يحمل نصف الحقيقة، ولعله النصف غير المهم، لأن أكبر مشكلة تواجه الإنسان هي ليست في علاقته بالكون، بل علاقته بأخيه الإنسان.
فالكون نعيش معه في حالة سلام وتوازن منذ 500 مليون سنة من خلال جسدنا الذي ينتسب إلى عديدات الخلايا والذي يشكل قمة التكوين في الطبيعة، ويمثل دماغنا أعظم تجلي للطبيعة، وسارت العلوم في معرفة الفيزياء والكوسمولوجيا والذرة والبايولوجيا والكيمياء والطب والجيولوجيا، ولم تتوجه إلى اكتشاف أعظم قارة أي رأسنا الذي نحمله وبدأت منذ فترة قريبة في التوجه إلى هذا الحقل حيث يعكف 2500 عالم في أور.با (غير النشاط الذي سبق في اليابان وأمريكا) على معرفة عمل النفس والجهاز العصبي والروح؟!
ونحن لا نعرف الآن حتى جغرافيا المادة العصبية على وجه كاف، فكيف بعمل النفس من خلال الدماغ؟ ودماغ آينشتاين الذي تبرع به قبل موته مازال يدرس بدون معرفة سر العبقرية التي مشت فيه وتجلت بنظرية النسبية التي قلبت مفهومنا عن الزمان والمكان المطلق لنرى العالم في صورة متصل الزمان ـ المكان.
هذا الانحراف أو هذا التوجه في مسار العلوم والذي سار عشوائيا بدون أي تخطيط، جعل عالم النفس السلوكي الأمريكي (سكينر) يقول بصورة لا تخلو من السخرية بأن أرسطو لو دخل زماننا الحالي فإنه سيشترك بدون أي عناء في محاورات السياسيين الذين يقودون (بكل أسف) العالم الحالي، في حين يقبع المفكرون والعلماء والفلاسفة بدون أي أثر في مجريات الحياة الخطيرة، إلا أن أفلاطون وأرسطو سيسكت كأي طالب متواضع أمام الكم المعرفي في أسرار الخلية أو أفكار النسبية و ميكانيكا الكم والشيفرة الوراثية.
إن التعقيد الرهيب في فهم جدلية النفس وحركة المجتمع تخلق تحدياً ليس من السهولة الاستهانة به فهناك تداخل رهيب من عناصر التأثير والتنافر والتجاذب، مع هذا فإن توجه القرآن يؤكد على أن هناك شيء ثابت في الوجود أي قوانينه وسننه التي لا تتبدل ولا تتغير.
وكما ذكرنا سننه تلك التي تسيطر على النفس والمجتمع. (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا)؛ فالوجود مضبوط بالسنن، ولن ترفع السنة ليوضع مكانها سنة جديدة. كما أن السنة لن تغير طريقها وهي تمضي في حركتها، لن يحدث تغير لا كلي ولا جزئي. ولم يبق أمامنا إذاً إلا محاولة فهم هذه السنة، وهذا يحمل في تضاعيفه تكريم رهيب للإنسان في أنه يستطيع فهم السنة ويتعامل معها.
انتحارية النزعة الحربية
ويتفرع من فهم فكرة القانون والحياة أمر على غاية الخطورة، وهو علاقة السنة بالفهم فالتسخير؛ فالتنبؤ؛ بالعلم، فالعقل الإنساني يستطيع الفهم، وبذا يستطيع أن يتعامل مع الآية الكونية والنفسية والاجتماعية، وإدراك ميكانيزم عمل السنة يمنح تسخيرها أي الخدمة المجانية، والعلم هو القدرة على التنبؤ، من خلال ضبط السنة، وهو ما يطمح إليه العلماء اليوم.
يقول ستيفن هوكنج في كتابه قصة قصيرة للزمان (لقد أعدنا تعريف مهمة العلم، بكونها اكتشاف قوانين، تمكننا من التنبؤ بالأحداث ضمن الحدود التي يرسمها مبدأ الارتياب. ولكن يبقى السؤال: كيف؟ أو لماذا كان اختيار القوانين والوضع الأولي للكون) وفي فترة النظام النيوتوني السابق اقترب العلماء من مفهوم، تبين فيما بعد أنه ضبابي، أي أن الكون هو بمثابة ساعة أو آلة كبيرة سوف يتم الكشف عن قوانينها والسيطرة عليها، وتبين أن الوجود أكثر خدعة وأوغل في التعقيد، وأرعب في إمكانية الإحاطة به، وأكثر هلامية من الإمساك بقوانينه، وهذا يقودنا إلى محاولة اكتشاف العلاقة بين القانون والحرية. وكان الأثر الفلسفي لميكانيكا الكم الدور البارز في إدخال فكرة الاحتمالية في فهم الوجود (مبدأ الارتياب لفيرنر هايزنبرخ وبول ديراك ونيلز بور).
 مع انبثاق المعاصرة من خلال فهم أفضل للكون، وانزياح الأسطورة، واضمحلال الخرافة وانقشاع المفاهيم غير المؤطرة والمرسخة بالقالب العلمي، وبروز علوم جديدة، واختراق فضاءات معرفية جديدة وجريئة، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن العلم لا نهاية له وهو ينمو من خلال الإضافة والحذف وليس الإلغاء كما يخطر في ذهن البعض وإلا فهو ليس بعلم.
مع انبثاق المعاصرة من خلال فهم أفضل للكون، وانزياح الأسطورة، واضمحلال الخرافة وانقشاع المفاهيم غير المؤطرة والمرسخة بالقالب العلمي، وبروز علوم جديدة، واختراق فضاءات معرفية جديدة وجريئة، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن العلم لا نهاية له وهو ينمو من خلال الإضافة والحذف وليس الإلغاء كما يخطر في ذهن البعض وإلا فهو ليس بعلم.
صحيح أن التغير يعم الوجود وهو قانون إلهي أن كل يوم هو في شأن، وأن الخلق في حالة زيادة، فهو كون من نوعية نامية ديناميكية، إلا أن هذا النمو والزيادة أيضاً لها قانونها الذي ينظمها. بقي علينا أن نقترب لإدراك هذا القانون المتغير أيضاً، وأن الكون أعظم من كل ما يمكن وصفه به.
وقبل أن أجمع هذه المقدمة الهامة والضرورية في ترسيخ مفهوم السير في الأرض، حيث أن القرآن يأمرنا أن نتوجه إلى تحصيل علم هو خارجه، فالأمر بالسير هنا هو في الكون وليس في الكتاب. وإذ أغفل المسلمون هذه القواعد الذهبية من أجل إيقاد هذه النار المقدسة، النظر في الكون، وإعمال العقل لفهم سننه ، والانطلاق في الاستفادة من التسخير المودع بالكمون في تضاعيفه، كانت النتيجة طبيعية أن يطويهم التاريخ ليتقدم لقيادته من هو أهل للصلاح أكثر، وهذا يجعلنا نفهم بعداً جديداً في الصلاح الذي أرادته الآية القرآنية (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون).
من خلال هذا التأسيس لمفاهيم بعينها يمكن الآن أن نرى بنور أفضل الأحداث التاريخية كمثل الواقعة الفظيعة التي بين أيدينا، حيث كاد جذع الشجرة العثمانية أن يقطع ولما يقف على قدميه، ففي صيف عام 1402 ميلادي حصد سيف تيمورلنك أرواح عشرات الالآف في سهل أنقرة التي لا يعرف أهل العاصمة التركية اليوم عنها شيئاً، كما هو الحال في معركة العقاب التي قصمت ظهر أهل الأندلس في عام 1212م.
كان تيمورلنك كما وصفه المؤرخ البريطاني جون أرنولد توينبي يحب تخليد ذكراه في التاريخ بالرعب الذي لا حدود له، وبالفظاعات المروعة، وبالدماء والرؤوس المقطوعة كي يبنى منها المآذن وبالطبع مقروناً باللعنات التي لا تنتهي إلى يوم الدين من المذبوحين وكتَّاب التاريخ ومراجعي الوقائع التاريخية كما نفعل اليوم.
 قال توينبي عنه في كتابه القيم دراسة التاريخ وهو يبحث انتحارية النزعة الحربية وأنها السلاح الذي يقضي على صاحبه في النهاية (وأفظع ماارتكبه تيمور من أفعال التدمير كان ضد شخصه فقد جعل اسمه خالدا بأفعال التدمير التي محت من ذهن الأخلاف كل ذكرى للأفعال التي كان يمكن أن يذكر بها ذكرى حسنة .
قال توينبي عنه في كتابه القيم دراسة التاريخ وهو يبحث انتحارية النزعة الحربية وأنها السلاح الذي يقضي على صاحبه في النهاية (وأفظع ماارتكبه تيمور من أفعال التدمير كان ضد شخصه فقد جعل اسمه خالدا بأفعال التدمير التي محت من ذهن الأخلاف كل ذكرى للأفعال التي كان يمكن أن يذكر بها ذكرى حسنة .
إن اسم تيمورلنك عند أكثرية الناس الساحقة، يعني شخصية عسكرية اقترفت قدراً من الفظائع طوال فترة الأربعة والعشرين عاماً من حكمه؛ مثلما اقترفه الملوك الآشوريون خلال مائة وعشرين سنة.
إننا لنتخيل المجرم الذي سوَّى مدينة اسفراين بالأرض عام 1381، وكدس خمسة آلاف رأس بشرية في المآذن في زيري في نفس السنة، وطرح أسراه من لوريستان أحياء من أعلى المنحدرات عام 1386. وذبح سبعين ألف شخص وجمع رؤوس القتلى في هيئة مآذن في أصفهان عام 1387 . وذبح مائة ألف أسير في دلهي عام 1398 ، ودفن أحياء أربعة آلاف جندي مسيحي من حامية سواس عقب القبض عليهم عام 1400.
وابتنى عشرين برجاً من جماجم القتلى في سوريا عامي 1400 - 1401 . إن تيمور قد جعل ذكراه تختلط في أذهان أولئك الذين يعرفونه بمثل هذه الأفعال بذكرى غيلان السهب ـ مثل جنكيزخان وأتيللا وأترابهما ـ الذين أمضى تيمور النصف الأول من حياته وأحسنه، في شن حرب جهاد ضدهم .
ابن خلدون في حضرة تيمورلنك
إن جنون العظمة التي جعلت تيمور يصاب بجنون التدمير، قد تحكمت فيه فكرة واحدة مدارها الإيحاء إلى مخيلة الإنسانية بإدراك قوته الحربية عن طريق الإساءة إلى البشر إساءة منكرة.
حتى الآن لم نفهم بعد المغزى التاريخي العميق لهذا الارتطام التاريخي، حتى ابن خلدون المرتعب من هذا (الغول) الذي دلوَّه بسلة من سور دمشق لمقابلته بعد أن ترك الملك المصري (الظاهر برقوق) دمشق إلى مصيرها تجاه تيمورلنك بعد أن سمع عن محاولة انقلاب ضده في مصر!
لم ينتبه ـ وليس بإمكانه ـ إلى المغزى التاريخي الذي سوف يتجلى بعد قرون، كل ما فعله ابن خلدون أنه كان حريصاً على سلامة جلده من هذا الذي اعتاد شرب الدماء، والتلذذ بقطع الرؤوس (ذلك الدماغ الذي يمتلك كل واحد منها مائة مليار خلية عصبية!) ، لذا قبَّل يده، وتظاهر له بأنه ينتظره منذ فترة بعيدة، لأن المنجمين كانوا يتوقعون قدومه؟! ـ صاحب العقل السنني الصارم ولاغرابة حيال الغيلان ـ من أمثال اليهودي ابن زرزر منجم الملك الأسباني ألفونسو الثامن، كذلك أعطاه دابته الممتازة ـ سيارة المرسيدس لتلك الأيام ـ حينما رأى رغبة ملك (التتر كذا !) فيها، بالإضافة إلى علب الحلوى المصرية الفاخرة لإطعامه ـ بالطبع بعد أن يتذوقها ابن خلدون كيلا تكون مسمومة على عرف تلك الأيام!.
وفي النهاية يتحفنا ابن خلدون بمنظر كاريكاتور عاصره في حضرة تيمورلنك عن رأيه في منصب الخلافة! الذي يستجديه أحد الذراري من بقايا خلفاء بني العباس الذين نجوا من الذبح من قلعة دمشق من جنود تيمور! بدعوى أن (إن هذه الخلافة لنا ولسلفنا وإن الحديث صح بأن الأمر لبني العباس ما بقيت الدنيا؟!).
كان تيمورلنك أعقل من تلك المخلوقات الممسوخة فجمع له القضاة للفتوى، ولم يكن أمام ابن خلدون ـ الفطن في مجالس الغيلان ـ إلا بالموافقة على ما خرج به فقهاء تيمور أن لا أحقية له في الخلافة، ولاغرابة لأن خطط تيمور لم تضم بعد إلى مشاريعها احتلال مصر، وكانت معركة أنقرة المرعبة أقل من طلب الخليفة الدعي عندما هرب طالباً اللجوء السياسي عند بايزيد خان وأصر تيمور على إقامة الحق واسترداد الفارِّ؟!)
انتبه توينبي إلى طرف من المغزى التاريخي في حدين الأول هو (ذلك أن نزعة تيمور الاستبدادية باكتساحها كل شيء وجدته في طريقها في اندفاعها الأرعن نحو دمارها نفسها، قد أوجدت فراغاً جرَّ العثمانيين والصفويين في النهاية صوب ارتطام، كانت فيه الضربة القاضية على المجتمع الإيراني)
والثانية وهي الأهم (ولكن بعد ما إتخذت أفعال تيمور سبيلها على النسق التدميري المتقدم وقف تقدم الإسلام في أوراسيا إلى الأبد، بل تحول المغول والكالموك بعد ذلك بقرنين إلى المذهب اللامي من بوذية ماهايانا).
ويبدع مالك ابن نبي في تعليقه على ظاهرة العمى التاريخي هذه والارتطام الحضاري ويدمج بين تحطيم قوة (طغطميش) التي كانت في طريقها لاحتلال روسيا، والتي يحللها توينبي على الشكل التالي في ظروف افتراضية ((ففي ظل هذه الظروف الافتراضية: ربما تجد روسيا نفسها اليوم داخل نطاق امبراطورية تضم نفس مساحة الاتحاد السوفيتي الحالية، ولكن مع اختلاف الأهمية؛ امبراطورية إيرانية تحكم فيها سمرقند موسكو، عوضاً عن أن تحكم موسكو سمرقند) ، وتحطيم قوة بايزيد الأول المستعدة للانقضاض على أوروبا.
جاء في كتاب وجهة العالم الإسلامي لمؤلفه المفكر الجزائري مالك بن نبي مايلي ص (200 - 203): (لقد قام تيمورلنك في الواقع بعمل لم يكن يستطيع إدراكه حتى بعد انتهائه منه، لأن مغزاه التاريخي الحق لا يمكن أن يظهر إلا بعد عدة قرون.
إن مسألة كهذه قد تتركنا مشدوهين بحجة أنها ذات طابع ميتافيزيقي، ولكنا لكي نعطي للأحداث تفسيراً متكاملاً يتفق مع مضمونها كله يجب ألا نحبس تصورنا لها في ضوء العلاقات الناتجة عن الأسباب، بل ينبغي أن نتصور الأحداث في غايتها التي انتهت إليها في التاريخ.
ومن هذا الجانب قد يلزمنا أن نقلب المنهج التاريخي: فنرى الظواهر في توقعها بدلاً من أن نراها في ماضيها، ونعالجها في نتائجها لا في مباديها، فلكي نفهم ملحمة تيمورلنك ينبغي ـ مثلاً ـ أن نسأل أنفسنا: ماذا كان يمكن أن يحدث لو أتيح لطغطاميش أن يحتل موسكو، ومن بعدها وارسو؟ ولو قدر لبايزيد أن ينصب رايته على أطلال فيينا، ثم على أطلال برلين؟ لو حدث هذا لأذعنت أوروبا حتماً لصولجان الإسلام الزمني المنتصر، ولكن ألا يدفعنا هذا إلى أن نرى توقعاً مختلفاً تمام الاختلاف عما حدث فعلاً كان سيحدث في التاريخ؟
كانت النهضة الأوربية التي ما زالت في ضمير المقادير ستنصهر في (النهضة التيمورية) ولكن هاتين النهضتين ـ على الرغم من عظمهماـ كانتا مختلفتين، فلم يكن مغزاهما التاريخي واحداً، فلقد كانت الأولى فجراً يفيض على عبقريات جاليلو وديكارت وغيرهما، بينما كانت الأخرى شفقاً يغلف الحضارة الإسلامية لحظة أفولها.
كانت إحداهما بداية نظام جديد، وكانت الأخرى نهاية نظام دارس، وما كان شيء في الأرض يستطيع أن يدفع عن العالم الليل الذي أخذ يبسط سلطانه آنئذ على البلاد الإسلامية في هدوء، فلو أن تيمورلنك كان قد اتبع دوافعه الشخصية لما استطاع شيء أن يحول دون نهاية الحضارة الإنسانية. فهناك حسب تعبير إقبال (خطة للمجموع) هي التي تكشف عن اتجاه التاريخ.
لماذا حال تيمورلنك دون قيام بايزيد وطغطاميتش بنشر الإسلام في قلب أوروبا؟
والجواب لكي تتابع أوربا المسيحية جهدها الحضاري الذي لم يكن العالم الإسلامي بقادر عليه منذ القرن الرابع عشر، حيث كان في نهاية رمقه، فملحمة الامبراطور التتري تجلو غاية التاريخ، إذ كانت نتيجتها متطابقة مع استمرار سير الحضارة ودوامها، كيما تتعاقب دوراتها، ويتم الكشف الخالد عن العبقريات التي تتناوب على طريق التقدم) (فإن سيف تيمورلنك هو الذي شق الطريق أمام الحضارة الغربية الوليدة وسط أخطار الغروب التي كانت تخيم على العالم الإسلامي، فهل يمكن في ظروف كهذه أن نتحدث عن نوع من (العمى)؟ وهل لا يمكن أن نرى في ذلك أمارة على نوع من التجلي العلوي وراء تصرفات تيمورلنك ؟) اهـ .
وفي مكان غير بعيد عن سيف طغطميش جلس رجل يرقب السموات العلى (كوبرنيكوس) ليقول على خوف أن الأرض ليست مركز الكون، بل أن الأرض ليست أكثر من تابع يدور حول الشمس. وكانت هذه العاصفة العقلية الأولى التي غيرت المصير الأوروبي برمته.